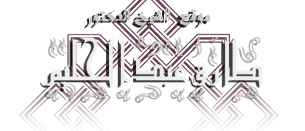الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
مقدمة
تتسارع خطى الكفار، سواء الصليبيين أو الصهاينة من الخارج، أو المرتدين عن الإسلام من حكام ودهاقنة الداخل، في إضلال العوام، وتبديل دينهم وعقائدهم، بأخبث الطرق وأكثرها خفاء بالنسبة للعاميّ، وهي ما أسماه الله سبحانه "تلبيس الحق بالباطل"، فقد قال تعالى "لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ". وهذا حال الكفار مع عوام المسلمين عامة، وأهل الكتاب في موضع الآية خاصة. والتلبيس هو خلط حقٍ بباطل يراد إشاعته. ويعلم هؤلاء الكفار جميعا أن قدرة التمييز بين الحق والباطل تتمايز وتختلف بين الناس، فمنهم العالم الذي سيظهر على الحق، ويتبين له الخلط بمجرد أن يسمع ترانيمهم. وهناك العاميّ، وهو الذي لم يتأهل للتمييز أو التفرقة بين الحق، وفرز الباطل وتعيينه. وهذا حال العوام، كانوا وسيظلوا إلى أبد الدهر. وقصص القرآن في كلّ موضعٍ دليل على ذلك.
من المقصود بالعاميّ؟
وليكون واضحاً من المقصود بالعامي، فإن الناس، في التصور الإسلامي من زاوية العلم ثلاثة أصناف، عالم، وكال علم وعامي. فالعالم هو من درس الشريعة دراسة متأنية عميقة، في غالب مجالاتها، وكانت له، نتيجة ذلك العلم، مدونات مكتوبة ومسموعة، واضافات علمية مقبولة في الوسط العلمي، ثم لم ينحرف إلى أحد تلك الأركان التدليسية جريا وراء دنيا يصيبها أو منصبا يتقلده. ثم طالب العلم، كما يدلّ الاسم، من غلبت عليه الدراسة الشرعية، وطلب العلم في مظانه، بطريقة منهجية، ولم يثنه عمل أو ولد عن هذا الغرض. عدا هذين الصنفين، فهو العاميّ. وكون المرء عامي لا يعني أنه لا يعرف شماله من يمينه! بل العامي يعلم صلاته وصيامه، وكثير منهم يعلم عن حكم الزواج وبعض أحكام الطلاق، وغير ذلك مما يدخل في دائرة الحياة الاجتماعية اليومية، وإن لم يعلم أدلتها أو الخلاف فيها.
وحال العوام، من جَهْلٍ بالعلم، ومن ثم عدم القدرة على التمييز، ليس عيبا فيهم، إذ ليس من المُفترض أن يكون كل الناس من علماء الشريعة وخبراء الأصول. ولو كان هذا لتعطلت أعمال الناس، ولتوقفت مرافق الحياة، وضاعت مصالح الخلق. قال تعالى "فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ" التوبة 122. فيتوجب أن تنفر من كل فرقة، أو مجتمع من المسلمين، طائفة للفقه في الدين، ولتعليم الناس، ممن رجع من الجهاد أو ممن لم يقدر على العلم بذاته. وتلحظ استعمال القرآن لكلمة "النفر" التي تتصاحب عادة بالنفير للقتال، إذ هذا اللون من النفير للعلم يلحق بنفير القتال، ويتوجب كما يتوجب القتال. كذلك نلحظ في الآية أنّ نتيجة تفقه تلك الطائفة هي تحذير العامة، من الكفر وألوانه، ليحذروا مكر العدو وخبائثه وخبثائه.
وتوجه الكفار، أو ممثلوهم، إلى تخريب العوام، رغم ضحالة ما لديهم من علم، وقلة التزام الكثير منهم بفروض الدين، هو أنهم يمثلون القوة الهائلة المخبوءة في الجمع الإسلامي، والكتلة العظيمة التي، حين تحركت بفاعلية مرة من قبل، قلبت موازين الدنيا لما يقرب من ثلاثة عشر قرنا! نعم، فالعوام هم مادة الإسلام، ومحل دعوته، كما إنهم مخزون قوته وزخمه. فمن يكسب عقولهم وقلوبهم، فائز في معركة الحضارة والبقاء.
فتبديل عقائد العامة، دون إفزاعهم، وإعادة تشكيلها تحت قبة الإسلام العام، مع إخلاء المحتوى من مفاهيمه ومبادئه، وتبني وجهة النظر الغربية الليبرالية، تحت مظلة "إسلام" ما، هو نصر أكبر لتلك القوى، إذ تتحصل مصالحهم دون مواجهة شاملة مع "العوام" أو القوى الإسلامية الكامنة، والتي ثبت أنهم يخسرون فيها، إما الكثير أو ما يكفي لخرابهم.
معالم التخريب الفكري الكبرى
وكان تسرّب تلك الفيروسات الفكرية هو الشغل الشاغل لعشرات المستشرقين، ومئاتٌ ثم آلاف من أتباعهم المخلصين من منافقي الأمة، منذ الغزو الفرنسي، في تاريخ لا محل لسرده هنا. لكن كانت المحطات الكبرى فيه، هي:
- تكوين المحاكم المختلطة
- تبديل قواعد وعقائد الجيوش المسلمة ليصبح ولاءها لقادتها لا لدينها وشعوبها المسلمة
- إعلان "الدين لله والوطن للجميع" وهو مبدأ الوطنية
- تبني النظام الديموقراطي كشكل للحكم وإصدار التشريعات.
- حركة "تحرير المرأة"، أو تخريبها بتعبي أدق.
- تبني مفهوم "الوسطية" بمعناه المنحرف، وهو أن الوسط محله بين حق وباطل، لا بين باطلين.
- تبني مفهوم "التجديد" تحت زعم التطور الذي تشهده البشرية في كل المجالات، فلم لا يكون في الدين!
وكان من أهم النقاط التي أفرزتها تلك المحطات، مفاهيم ومواقف، تبنتها مجموعة من "الدعاة" الضالين المضلين، على رؤوسهم العمم والغتر، يبدؤون حديثهم بحمد الله والصلاة على رسوله ﷺ، وينتهون بالغض من دين الله، وترويج كل ما هو مخالف لسنة رسوله ﷺ. وأعان على ترويج باطل هؤلاء الخارجين عن دين الله، الحاملين للأجندات الصليبية الصهيونية، بخفاء وخبث، لا يدركه عقل العامة، ظهور التلفاز والانترنت، ومنصات التواصل، التي كانت وباء ووبالاً على المسلمين. سمٌ ناقع في شكل حلوى مُسكَّرة!
مراحل التخريب الفكريّ:
وقد غطت تلك الجهود الرامية إلى تحييد العامة دينيا وتخريب ولائهم للإسلام، موضوعيا، حقلين من الفكر الإسلامي، حقل الفقه، وامتدت مرحلته الزمنية من الغزو الفرنسي حتى يومنا هذا، ثم حقل العقائد، الذي بدأت تظهر ملامحه مع بداية القرن الحاليّ، والذي تزامن مع الغزو العنكبوتي داخل البيوت، وبعد أن ضمنت القوى المعادية أنّ المرحلة الأولى تمت بنجاح بنسبة كبيرة، عبر الشعوب المسلمة. وهذا الترتيب كان مهما بالنسبة للقوى المعادة للإسلام، إذ إن مهاجمة العقائد المستقرة أصعب كثيراً من الأمور الفقهية التي يمكن دائما وضعها في صورة "خلاف فقهي" لا أكثر! أمّا العقائد، فهي أكثر تعقيداً، فاحتاج الأمر لإنهاء المرحلة الأولى، حتى تكون الأرضية قابلة للغزو العقائدي المنحرف.
أولا: تخريب الوعي الفقهي
ففي مرحلة تخريب الوعي الفقهي، كما نوهنا، بدأ بموضوع تكوين المحاكم المختلطة، ثم بدأ ترويج أفكار الفساد من خلال السينما، مثل خلع الحجاب وعدم فرضيته، السماح بالاختلاط، وحق البنت في "الحب والحرية". وصاحب ذلك جهداً مسعوراً في انتاج أفلام الخلاعة والرقص الشرقي والغناء. كذلك ما حدث في مجال الفقه السياسي، حيث روجت فكرة عدم ضرورة الخلافة، وفصل الدين عن الدولة، وتبني مبادئ الديموقراطية التي لبسوها بالشورى. وكان الإخوان هم فرسان هذا الميدان البرلماني الديموقراطي، بعد انقلاب عبد الناصر، وانتهاء عهد الملكية والبرلمانية التي شُغِف بها جيل ما بعد سقوط الخلافة. وأفرز ذلك بعض خروقات للإجماع كنفي حدّ الردة، ثم نفي الحدود كلها، وقبول النصراني حاكما، بل وليّ أمر مطاعٍ كما قال كفار المداخلة. كما كان من رواد هذا التزوير والتدليس حسن الترابي السوداني والمرتد الغنوشي والريسونيّ التونسيين، ومحمد عمارة وسليم العوا المصريين، وعدد لا يستهان به من الأسماء التي لمّعها الإعلام، وفتح لها أبواب الأستوديوهات ببرامج ومقابلات، اغترّ بها وبهم العوام، فصاروا أعلاماً وهم في الأصل أفلاماً! وصرت إن ذكرت الحق كما هو مدوّن في كتب سلفنا، أو الكتاب والسنة، قيل لك: أأنت أعلم أم فلان الذي له برنامج كذا وكذا!
ثانيا: تخريب القاعدة العقدية
ثم لمّا غزت النت البيوت والعقول، وانتزعت الزمن انتزاعاً من أعمار الناس، بدأ ظهور طبقة جديدة من المدلسين والمنحرفين، يخرجون على الناس بتشوهات عقدية، يلبسونها بحقٍ ما. وهذه اللون من البشر، وإن كان موجوداً من قبل، إلا أنه كان محصوراً في علماء السلطان الرسميين، وفي المؤسسات الدينية التي سيطر عليها العسكر، أو الحاكم بالعسكر. وهذا الذي رأيناه منذ بداية هذا القرن التعس، هو ظاهرة جديدة، اختلط فيها الحابل بالنابل، وكانت عملية تمويه وتحريف واسعة المدى، بدأت بأفكار منها، "شركاء الوطن" عن النصارى، ثم انتقلت من ضرورة احترام حقوقهم، إلى تمييزهم، ثم إلى مساواتهم بالمسلمين في أنهم أصحاب دين صحيح، واستخدام آيات قرآنية تدليساً وافتراءً على الله. وكان من رواد هذا الاتجاه جماهيرياً، عمرو خالد الفاجر الضال، ثم طارق السويدان خويّه في الضلال والمروق. ثم من عملاء السلاطين أمثال على جمعة وأحمد الطيب، كما صدرت غرائبٌ من الصلابي الليبيّ. وكان من أشد واسوأ هؤلاء المداخلة، أتباع الهالك المدخليّ وأستاذه الجاميّ اليمنيّ، حيث اجتمع في بدعتهم وتدليسهم البعد الفقهي والعقدي، فصاروا يألهون الحاكم، ويدعون لطاعته ولو في معصية الخالق! يحاربون أتباع السنة، مع الحاكم الكافر الموالي للغرب، والحاكم بالشرع الوضعيّ المنافح عنه، المعادي للشريعة وحامليها والداعين لها!
ونحن اليوم نرى جيلاً، بل جيلين إن أردنا الحق، يحملان هذه الأفكار، ويرددون أدلة التدليس، ويعادون أهل الحق من حيث يرونهم "إرهابيين"، "تكفيريين"، "متشددين"، اختر ما شئت حسب موضع من يتحدث إليك من الليبرالية "الإسلامية"، إن صح التعبير!
هذا الوضع القائم حالياً، في واقعنا العاميّ، هو ما أطلقت عليه في مقالات أخرى، الكتلة الهلامية الضبابية العقيدة، التي تقف حائلاً، بين المسلمين وبين تحقيق حلم العودة للإسلام في حياتنا، من حيث كان من المفترض أن يكونوا هم الحاضنة الطبيعية لتلك الحركة المرجوّة، كما كانوا دائما في الماضي.
مصادر اضطراب العوام
والدوامة التي يعيشها العامي، وإن لم يعلم أنه يعيش في دوامة!، تأتي من أمرين، الأول هو مصدر المعلومات التي يخزّنها العامي في عقله، والثاني قدرته الخاصة على التمييز بين الحق والباطل.
ويختلف العوام في هذين الأمرين اختلافا شاسعا. فمن العوام من يدمن على سماع الشرائط المسجلة، مسموعة أو مرئية، لأحد المتحدثين، سواء معروفا أو غير معروف، إن ارتاح لطرحه ووافق ما يراه هو في المسائل عامة. وهذا أمر لا جناح عليه إن وفقه الله لمن يقول الحق ويتحدث بالصواب، في غالب أمره. لكن الواقع ينكر هذا، إذ غالب متحدثي النت مغرضون مدلسون، على علم مثل الددو والسويدان والريسوني وأمثالهم، أو مجاهيل تتحدث، لا يعلم أحد أين تعلم، وكيف وماذا!؟ وتتفاوت، حسب مرض كل متحدث، نوع البدعة العقدية أو التخريب الفقهي الذي يبثه في العامة. فمثلا، ذاك اللعين عصام تليمة، ربيب القرضاوي، الذي خرج مؤخرا على الناس بكتاب يقول فيه أن الحدود غير واجبة في الإسلام، بل هي مستحبة. وهذا قول مكفّر بذاته، من حيث هو مخالف لمعلوم من الدين بالضرورة ومعاند إجماع كل العصور. ومع ذلك تجد عددا من العوام المنتسبين لجماعة إسلامية أو من المهتمين بالشأن الإسلامي، يبرر لمثل هذا المروق.
والساري اليوم بين كافة مدلسي الأمة، بل منذ بداية القرن، هو بدعة القول بأن الجنة ليست حكرا على المسلمين، وأن كلّ صاحب دين، مخلص في اتباعه هو من أهل الجنة، وأن الحق نسبي لا مطلق، لا يصح أن نحتكره نحن المسلمون وإلا كنا طغاة فكريا! وهذه بلا ريب بدعة مكفّرة، يكفر القائل بها، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ويتبع هؤلاء عدد هائلٌ من العوام، يدخلونهم في الكفر دون أن يشعروا (أي العوام)، أنهم وقعوا فيما يحذرون منه. والغرض من هذه البدعة العقدية معروف، وهو تقريب المسافة بين المسلمين وبقية العقائد المحرفة أو الباطلة. ومن ثم يفقد المسلم هويته وينحرف عن دينه الأصلي، ويصبح أخا للمثُلث واليهودي والبوذي والمجوسي، فكلهم سواء في نظر الله سبحانه، حاشا لله من مثل هذا الكفر.
العوام وحقيقة "التكفير":
ثم نقطة هامة، تعرضت فيها عقلية العوام لتخريب ممنهج منظم، بنفس النهج والمنطق والتدليس. فإلى جانب تمييع حدود الإسلام والكفر، فقد زرعوا فكرة الرعب من "التكفير"! فجعلوا العوام يعتقدون أنه لا يصح ولا يجوز تكفير أحدٍ من الناس، طالما نطق بالشهادتين، مهما ارتكب من أفعال الكفر الواضح الجليّ المتفق عليه، فلا يزال لا يجوز إطلاق الكفر عليه أبداً. واخترعوا كلمات غريبة أضيفوها لقاموس المصطلحات الشرعية، مثل "هذا كثير!" أو "شنيع" أو غير ذلك، لكن لا يمكن تكفيره، مهما كان كفره بيّنا الشمس في رائعة النهار! وأذكر ما عانيناه في السبعينيات من رمينا باسم "التكفيريين" حين قلنا بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وموالاة أعداء الدين! وبالطبع، فإن هؤلاء المدلسين يميعون الآية والحديث ليوافق غرضهم. وفي هذا المقام، استعملوا حديث رسول الله ﷺ الصحيح "أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه" وورد بألفاظ متعددة في البخاري ومسلم.
الحديث عن حديث "أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر":
لا شك أن ظاهر الحديث فيه تحذير وتخويفٌ من التساهل أو التسرع في تكفير الغير، خاصة ممن ليس لديهم علم شرعيّ يكفي للتمييز بين المناطات المختلفة.
لكن لنا هنا تعليقان:
- أن الحديث ليس فيه نهي عن تكفير من يفعل الكفر بإطلاق، فليس في نصه ولا ظاهره ولا مفهومه هذا النهي. إنما فيه الحذر لمن هم من العوام، أو من لم يكن متأكدا من مناط التكفير. أما من كان على علم، وصح له معرفة المناط، فتكفير المعين جائز، بل ضروري في بعض الحالات، بإجماع أهل العلم، إلا عند أهل الأهواء من المرجئة.
- أن الحديث دليل على خطأ من قال بعدم تكفير من وقع منه الكفر، بمناط صحيح، مثل القائلين بدخول اليهود والنصارى الجنة، أو صحة دينهم، أو انكار حد من حدود الله مما أجمع عليه، ومثل تلك الأمور الظاهرة. وبيان ذلك: هو أن من قال لرجل على ظاهر الإسلام: يا كافر، فإما أن يكون ذلك بسبب ظاهرٍ كما ذكرنا، فليس على القائل شيء، بل هو حافظ لحدود الإسلام. وإن لم يكن كذلك، فإن الحديث يدل على أن القائل هو الذي يجب أن يُكَفّر، من حيث إنه اعتبر فعلاً من أفعال الإسلام الصحيحة كفراً، فيصير بذلك كافراً. سبحان الله! أيكون مؤدي الحديث التسرع في تكفير المدُّعى عليه هنا، لمجرد أنّ القائل أقام دعوى غير صحيحة!؟ لا يكون بالطبع. إذن ففعل التكفير هنا، واقع على الجهتين، وهو ما يثبت أن التردد المطلق في التكفير، والتوقف عن تكفير الكافر الظاهر الكفر بأقواله الثابتة، هو بدعة مضادة لهذا الحديث. ومثل هذا المعنى مروي عن مالك وغيره، والمحققون على أن القائل لا يكفر، بل تعود عليه معصية التكفير، إلا إذا كان المدُّعى عليه كافرا بحق، فلا يؤوب بمعصية، بل يكون ممن يميّز الخبيث من الطيب. فالقول هنا أن مناط التكفير في المُدّعى عليه هو الحكم في ذلك، لا منع التكفير مطلقاً.
وتكفير المرتد باب من أبواب الفقه تجده في كل مدونة فقهية، بلا استثناء. وبطبيعة الحال، فإنه يجب أن تتحقق الشروط وتنتفي الموانع ليصح الحكم. فإذا نظرنا إلى المثال الذي ضربناه بشأن أهل الكتاب، وجدنا أن الشروط متحققة من حيث إن الموضوع ابتداء من المعلوم من الدين بالضرورة، فلا محل للجهل فيه، ثم لا تأويل فيه من حيث أن المؤولين استخدموا آية "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" البقرة 65. وهؤلاء هم ممن ينسبون أنفسهم للعلم. وهذه الآية لا تدل على قولهم البتة، وهم يعلمون ذلك، إذ مسطور في كلّ كتاب للتفسير أن هذه الأصناف هي فيمن آمن برسوله في زمنه، لا بعد بعثة الحبيب المصطفى ﷺ، فإن هذا القول عبث بالشريعة وضرب الكتاب بعضه ببعض. يقول ابن كثير عن السدي "فكان إيمان اليهود: أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى، عليه السلام؛ حتى جاء عيسى. فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى، فلم يدعها ولم يتبع عيسى، كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل - كان هالك" تفسير ابن كثير سورة البقرة 62. فلا حجة في التأويل. ثم لا موانع للتكفير هنا، إذ ليس ثمة اكراه واقع على من يقول بهذا القول. فلا مراء في كفر من قال بهذا القول، وعلى رأسهم لابسي الغترة والشماخ من مدّعي العلم.
ثم إذا ذهبت تبيّن هذا للعامي، أجابهم بقوله: أأنت أعلم من شيخ الأزهر أو من السويدان، أو الريسوني أو من شئت؟ هذا ما قال فرعون "عن موسى عليه السلام "أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ"! أي من أنتم لتعترضوا على هؤلاء الأكابر؟! هذه فتنة العوام، على اختلاف درجاتهم فيها.
الفرق بين أثر الفرد وأثر الجماعة
ثم، بعد هذا البيان المختصر، نود أن نجيب على شبهة لدى الكثير من العوام، وهم في حقيقة الأمر لا يعرفون أن لديهم شبهة أصلاً. ذلك أنهم يختلطون في جلساتهم، سواء مع الرجال أو عائليا بالتزاور، مع آخرين من المنتمين لهذه الجماعة أو تلك. ويرون، في اخلاطهم هذا تدين مقبولٌ، وحرص على كثير من الواجبات، واحتشام وتحجب، وإقدام على المسجد وقراءة القرآن، فيقع في عقل العامي من أهل السنة، أن موضوع الجماعة هذا لا أثر له، بل ويحيّده من جهتها، وإن سمع عنها ما لا يرضي. فالواقع أمامه يشهد بحسن دين وخلق وسلوك من ينتمون إليها، فلماذا يهاجمها الشيخ فلان أو العالم علان؟
وهذا أمرٌ نفسيّ مفهوم. فالفرد العاميّ لا يتجاوز نطاق تحليله أبعد مما تراه العين، وتسمعه الأذن.
لكن الخطر ليس في سلوك هذا الفرد أو ذاك من تلك الجماعات، فوالله قد عرفت أشخاصاً لا مثيل لهم في عمل الخير والجري على مصالح الناس، وهم منتمون لتوجهات إرجائية خطيرة، مع ذاك الجهد الحسن. الأمر يتعلق بحركة الجماعة كلها كوحدة واحدة، وهو ما لا يشعر به الفرد فيها، ولا يكاد يراها من هو خارجها. هذه الكتلة كلها تتحرك بعقيدة وأيديولوجية منافية مناقضة للسنة، لا تظهر تفاصيلها في تصرفات الفرد، وهذا يعم كافة الجماعات المسماة بالإسلامية، كالإخوان وحزب التحرير وغيرهما. المصيبة في أن قيادات تلك الجماعات تستخدم الكم الرقمي للمنتمين إليها الترويج بضاعتها المزجاة، وسواء صلح الفرد شرعا أو خاب، فإن انتماءه للجماعة هو الأصل في العلاقة، لا صحة دينه أو التزامه، وهو مبدأ "الولاء قبل الكفاءة". فلذلك ترى إخوة في مركز كذا وهيئة كذا ومؤسسة كذا، عليهم سمات التدين، وعملهم فيه خير كثير للناس من حولهم، لكنهم، ولا يؤاخذني أحد في التعبير، كالثيران التي تُربط أعينها لتدور في الساقية، لا تعرف أنّى تتجه. ضف إلى ذلك تلك العلاقات الفردية أو الأسرية، فتجد العامي السني يميل، دون أن يدري لهذا التوجه، أو يدافع عن أفراده على أقل تقدير. لذلك فإن الكثير من العلماء، ومنهم ابن تيمية، يرون أن عوام أهل البدعة قد يُعذرون بل ويثابون إن لم يصلهم علم عما هم فيه.
ووسط هذا الكم الهائل من العوام، تجد راحلة أو رواحل قليلة، كما قال الحبيب المصطفى ﷺ "إنما الناس كالإبل المائة، لا تكاد تجد فيها راحلة" البخاري، يريد الله بها الخير، وهم مراد دعاة الحق. والراحلة هي الناقة القادرة على تحمل مشاق الطريق، فما أدقه من تعبير!
المتحدثون كثرٌ، لا تكاد تجد فيهم واحدا على حق. الواعدون كثر لا يكاد واحد منهم يصدق وعده. المُدَّعون كُثر، لا يكاد واحد منهم أن يقوم بدعواه.
اختلاط الأمر على العامي يأتي من عدة أمور متشابكة، منها شعوره بالعزة الذاتية التي تأبى أن يراجع النفس ويقر بالخطأ، ومنها سمعة المُتحدث حتى لو بالباطل والتطبيل الإعلامي، ومنها الجهل بالأصول المبدئية للعلوم، التي يمكن أن يعتمد عليها صاحب الفطرة السوية في اختيار طريقٍ سوي.
لكنما هي طبيعة الخلق، وواقع الأمر، يجب أن نفهمه ونعيه، ونتعامل مع الآخرين على أساسه...
فقط، كن أنت من الرواحل، لتجد لك راحلة ...
د طارق عبد الحليم
3 شوال 1442 – 15 مايو 2021