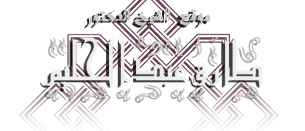الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد
من أهم الموضوعات التي يمكن أن يتعرض لها باحث في مجال تفسير القرآن، والعقيدة على السواء، هو الاستعمال القرآني للمثل، وجمعه الأمثال.
والمثل، والمثال، أسلوب بلاغيّ يخدم بيان فكرة ما، ونقلها من كلمة مجردة إلى صورة مجسدة، فتتضح للعيان، كما تتضح في الأذهان.
ولهذا البحث أصوله الممتدة في علوم اللغة وفي البيان والبلاغة. وهي لا شك واسعة الجوانب، ممتدة الأطراف، تشمل المعنى اللغويّ لكلمة "مَثَلْ"، وهي من المماثلة، التي فرّق بعض اللغويين بينها وبين التسوية، وإن اجتمعا في بعض الجوانب (راجع لسان العرب، حرف الميم، ج6 ص14، طبعة دار صادر). كما تتصل بمباحث التشبيه والاستعارة (راجع أسرار البلاغة للجرجاني ص 62 وبعدها، تحقيق محمود شاكر، ففيه مباحث رائعة بهذا الشأن)، وأدواته وفنّه، وهو موضوع واسع في ذاته، وعلى رأسه التشبيه بحرف "الكاف"، كما سنرى في غالب الاستعمال القرآنيّ.
ولكن القصد من مقالي هذا، هو إلقاء بعض الضوء على الاستعمال القرآنيّ المتكرر للمثال والأمثال، من حيث إنها قد تشتبه على بعض طالبي العلم في موضوع الصفات بالذات، وكذلك في موضوع آيات الله في الجنة والنار.
وسأتجنب هنا كثيراً من الجوانب اللغوية في هذا السياق، وسأقدّم نظرة جديدة في موضوع المثال، وإن لم تكن بدعاً من القول، إذ هي مجرد نظرة فاحصة في قالبٍ يختلف قليلاً عما قدّمه الباحثون في هذا المجال، وما أعظم وأجلّ ما قدّموا. وسأستعين ببعض أقوال أصحاب اللغة والتفسير فيما أقدّم إن شاء الله. والقصد، كما ذكرت، هو تقديم أسلوب بسيط مباشر لفهم هذا اللون من التعبير القرآني الفريد.
(2)
لا يكون الناظر في القرآن مبالغا إن قرر أنّ استعمال المثل والأمثال شائع عام متواصلٌ في كتاب الله "وَلَقَدۡ ضَرَبۡنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٖۚ " الروم 58. وهو أمر بدهيّ بطبعه، إذ إن الرسالة أصلاً هي تذكير بما مضى للأمم السابقة وتحذير من مثل عاقبتها، وعبرة للأجيال القادمة من قصص من سلف وغبر. وهذا، في حقيقته غرض ضرب الأمثال، ليعقلها العاقلون وينتفع بها العالمون.
ويمكن كذلك للناظر في القرآن أن يرى أن استعمال "المثل" قد ورد في ثلاثة سياقات مختلفة في الآيات القرآنية، وهي محور حديثنا في هذا المبحث.
- المثل، بمعنى ما يقرّب الصورة، كالاستعارة، والتشبيه، لوجود المشترك بين الأصل المُمَثل به، وبين الصورة المِثلية، وهو كثير في القرآن:
"ألم تَرَ كَيۡفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا كَلِمَةٗ طَيِّبَةٗ كَشَجَرَةٖ طَيِّبَةٍ أَصۡلُهَا ثَابِتٞ وَفَرۡعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿٢٤﴾ تُؤۡتِيٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِۢ بِإِذۡنِ رَبِّهَاۗ وَيَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡأَمۡثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ " إبراهيم
فالكلمة الطيبة هي الأصل، والمثل المقيس عليها، أو المشبّه بها إن شئت، هو الشجرة الطيبة، من حيث إنهما يشتركان في الإتيان بالأُكُل في كلّ حين بإذن الله.
"مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوۡلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلۡعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتۡ بَيۡتٗاۖ وَإِنَّ أَوۡهَنَ ٱلۡبُيُوتِ لَبَيۡتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ﴿٤١﴾ ِنَّ اللَّهَ يَعۡلَمُ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مِن شَيۡءٖۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَٰلُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِۖ وَمَا يَعۡقِلُهَآ إِلَّا ٱلۡعَٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾" العنكبوت
فالمشترك بين من يتخذون ولياً من دون الله، مع من يعتقد في بيت العنكبوت مأمناً يحميه، هو موقع المثال.
"مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ " البقرة 261
ففعل الإنفاق مثل مثل زرع الحبة التي تنبت سبع سنابل إلى سبعمائة سنبلة.
"فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَتْرُكْهُ يَلْهَثْ " الأعراف 176
فالمثل هنا هو الاشتراك مع الكلب في اللهث في كلتا الحالين، إن حملت عليه أو إن لم تحمل، كما قال ابن عباس "الكلب منقطع الفؤاد" (كشاف الزمخشري ج2 ص 131). فالكافر ضال سواء وعظته أم لم تعظه.
"ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشۡكَوٰةٖ فِيهَا مِصۡبَاحٌۖ ٱلۡمِصۡبَاحُ فِي زُجَاجَةٍۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوۡكَبٞ دُرِّيّٞ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٖ مُّبَٰرَكَةٖ زَيۡتُونَةٖ لَّا شَرۡقِيَّةٖ وَلَا غَرۡبِيَّةٖ يَكَادُ زَيۡتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوۡ لَمۡ تَمۡسَسۡهُ نَارٞۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٖۚ يَهۡدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُۚ وَيَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡأَمۡثَٰلَ لِلنَّاسِۗ" النور 35
وهي آية جليلة، مثّل الله سبحانه فيها نوره، بأنه أصفى وأنقة وأقوى من نور المشكاة في المصباح في الزجاجة التي ككوكب دريّ، وقوده من شجرة مباركة ليست من نواحي الأرض كلها، يضئ زيتها وحده دون مساس، وهو مجرد مثل للتقريب.
"وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا" النور 39
فأعمال الكفار مثلها كالسراب، لا حقيقة له، وإنْ خُيّل للناظر اللاهي غير ذلك.
"مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا كَمَثَلِ رِيحٖ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتۡ حَرۡثَ قَوۡمٖ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فَأَهۡلَكَتۡهُۚ" آل عمران 117
وما نلحظه ونثبته هنا، أنه في كل تلك المواضع أمر مشترك، هو أنّ المثل إنما يأتي بحرف "الكاف" التشبيهيّ، على الدوام "كمثل الكلب"، "كمشكاة"، "كمثل حبة"، "كمثل العنكبوت"، "كشجرة طيبة"، "كسراب بقيعة"، "كمثل ريح" ...
وهذا اللون من الأمثلة، يعطي العبرة ويجسّدالصورة، ويشترك مع الحقيقة في أحد معانيها، لكنه لا يساويها.
- أما السياق الثاني من المثال، فهو ما لم يأت فيه حرف "كاف" التشبيه.
"لَوۡ أَنزَلۡنَا هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ عَلَىٰ جَبَلٖ لَّرَأَيۡتَهُۥ خَٰشِعٗا مُّتَصَدِّعٗا مِّنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّهِۚ وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَٰلُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ" الحشر 21
"وَسَكَنتُمۡ فِي مَسَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ وَتَبَيَّنَ لَكُمۡ كَيۡفَ فَعَلۡنَا بِهِمۡ وَضَرَبۡنَا لَكُمُ ٱلۡأَمۡثَالَ" إبراهيم 45
فنرى هنا أمراً ظاهراً كذلك، وهو أنّ هذا السياق من الأمثال، ليس فيه قدر مشترك بين أمرين مختلفية، كما في السياق الأول، فالمافر ليس كلبا حقيقياً، والكلمة الكيبة ليست شجرة، وهكذا. أمّا في هذا السياق، فإن المثال من واقع متطابق. مساكن سُكنت، ومساكن َتسكنونها، كما قال تعالى "كَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمۡ قُوَّةٗ وَأَكۡثَرَ أَمۡوَٰلٗا وَأَوۡلَٰدٗا فَٱسۡتَمۡتَعُواْ بِخَلَٰقِهِمۡ فَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِخَلَٰقِكُمۡ كَمَا ٱسۡتَمۡتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُم بِخَلَٰقِهِمۡ وَخُضۡتُمۡ كَٱلَّذِي خَاضُوٓاْۚ أُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ " التوبة 69. فهنا المُمَثل والمُمَثل به، كلاهما فيه تسوية، لذلك حذف جزاء من يفعل من المخاطبين بالقرآن، إذ هي واضحة معروفة بالشبه.
أما في قوله تعالى "لَوۡ أَنزَلۡنَا هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ عَلَىٰ جَبَلٖ" فإن لو الشرطية هنا تقوم مقام الواقع الحالّ في كلام الله سبحانه، وهو ما رأيناه من حال موسى عليه السلام.
- والسياق الثالث، هو فيما أتى من أمثال تتعلق بما لا نعرف عنه في دنيانا، ولا مجال لتشبيهه بما نعرف، إلا اشتراكاً لُغوياً، مثل صفات الله سبحانه، وما هو من الآيات فيما في الجنة أو النار.
"مَّثَلُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونَۖ فِيهَآ أَنۡهَٰرٞ مِّن مَّآءٍ غَيۡرِ ءَاسِنٖ وَأَنۡهَٰرٞ مِّن لَّبَنٖ لَّمۡ يَتَغَيَّرۡ طَعۡمُهُۥ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ خَمۡرٖ لَّذَّةٖ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ عَسَلٖ مُّصَفّٗىۖ وَلَهُمۡ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ" محمد 15
فنلحظ هنا أمرين، أولهما أنّ الآية لم تأت بحرف الكاف، بل انتقلت من " مَّثَلُ ٱلۡجَنَّةِ" إلى "فيها أنهار ..." مباشرة. لكنها ذكرت أن هذا مثلٌ ولا شك.
فهؤلاء الأمران يمليان على المفسّر أن يفهم أنّ الجنة فيها أنهار من لبن وعسل وخمر وماء، لكنها، لأنها "مثل" فهي تشترك مع أنهارنا في الاسم دون الحقيقة، إذ ليس في الدنيا أنهار من لبن، ولا خمرٍ أصلاً، فلا واقع يُمثل به هنا. بل هو تسليم بمضمون اللفظ اللغويّ، ثم يكون على حاله التي يخلقه الله عليها. كما في قوله تعالى "وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ*كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ"، فهن لسن بيضاً ولكنه مثال اتفق فيه الساياق الأول مع السياق الثالث، بوجود حرف "الكاف".
فإذا نظرنا في صفات الله تعالى:
"لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ" الشورى 11
وهي جماع تفسير صفات الله جميعاً. وقد الله تعالى هنا أنه لا شئ "كمثله" ولم يقل "مثله". قال ابن منظور "وقوله تعالى: ليس كَمِثْلِه شيء؛ أَراد ليس مِثْلَه لا يكون إِلا ذلك، لأَنه إِن لم يَقُل هذا أَثبتَ له مِثْلاً، تعالى الله عن ذلك" لسان العرب حرف الميم. ثم قال تعالى "وهو السميع البصير". فبعد أن نقض المثلية بالتمام، فليس له مثال أو مثل، أثبت صفاته واضحة تامة، فتبين، كما رأينا في السياق الثالث، من الأمرين المذكورين، أن الصفة تشترك مع ما هو في الدنيا في المقام ةاللغويّ لا تتعداه، أمّا حقيقتها فهي عند الله. وهذا مدار عقيدة أهل السنة "إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل".
وقد أعرضت هنا عن الحديث عن المثل والمثال، في معنى أنه الغاية التي يُرتقى إليها، أو الآية كما في قوله تعالى "إِنۡ هُوَ إِلَّا عَبۡدٌ أَنۡعَمۡنَا عَلَيۡهِ وَجَعَلۡنَٰهُ مَثَلٗا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ" الزخرف 59. فإنه ليس مما فيه إشكال إن شاء الله
فلعل توضيح هذه السياقات فيه تقريب لبعض المعاني التي ترد على العقل، فتشتبه عليه. وكم في القرآن من معانٍ مخبوءة، تحتاج لعقول وقلوب واعية تنقب عنها، بلا ملل.
د طارق عبد الحليم
6 شوال 1441 – 30 مايو 2020
(تحميل)