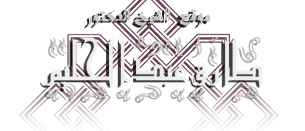الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد
(1)
أمران، خاص وعام، أريد أن أنوه بهما قبل أن آخذ في صلب موضوع مقال اليوم. أما العام، فيتعلق بدرجة الفتوى وتوجيهها حسب حال المستفتي، سواءً كان فرداً أو جماعة. فإن مراعاة الوضع العام للمستفتي يملى على المفتي أحكاماً بذاتها، تتغير حسب حاله وواقعه. وقد ورد ذلك عن ابن عباس رضى الله عنه فيما حكاه النووي في مقدمة المجموع: "قال الصيرمي: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العاميّ بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره، وله فيه تأويل، جاز ذلك زجراً له، كما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال: (لا توبة له) وسأله آخر فقال: (له توبة) ثم قال: "أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكيناً قد قتل فلم أقنطه"[1]. كما قرر الشاطبيّ نفس المعنى، قال " فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى أحد الطرفين كان التشريع رادا إلى الوسط الأعدل لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال فيه"[2]. فيجب على من يقرأ فتاوى العلماء في أيامنا هذه أن يأخذ ذلك في الاعتبار، إن كان من أهل النظر والاستبصار.
أما الأمر الخاص، فهو يختص بكلمة "دون" التي استعملتها في عنوان المقال. فهذا اللفظ يستعمل بمعنى "أقل" وهو ما قصدته في الجزء الأول من الهاوان، وبمعنى "غير" وهو ما قصدته في الجزء الثاني، فعلى القارئ الواعي أن يلحظ ذلك فيما يأتي من قول.
ثم تنبيه لازم استدرك به على مسألة "التكفير" حين يقع في كلامنا، وهو إنّ التكفير يفترق إلى ما هو عقيدة وإلى ما هو فقه، وقد بينت ذلك بتفصيل كافٍ في مقالي السابق "الفصام النكد وقضية التكفير"[3]. والشاهد هنا أن التكفير، في غالب حالاته، وإقامة حكمه على الدوام، لا يقع إلا بفتوى عالم رباني متخصص، مشهود له، وهو ما وقعت فيه الطوائف الحرورية، ومنها العوادية المعاصرة. وإنما يمكن للعامي أن يعرف عموماته ويدركها ويتعرف منها على ما هو من المعلوم من الدين بالضرورة، وظاهر ظهور الشمس في رائعة النهار، ككفر النصراني واليهودي وكل من ليس على دين الإسلام، وكفر من سبّ الرسول أو غيّر أو حذف من آيات القرآن عمدا بدعوى عدم صلاحيته لأي سبب من الأسباب. وهذا القول ليس فيه مما ذهب اليه الحرورية مما أصله لهم الحازميّ من إمكان أن يقوم العام بتكفير فاعل الكفر فيما يحتمل مناطات متعددة، كما بيّنا في المقال المشار اليه.
ومن الشواهد على ضرورة الرجوع إلى العالم ما جاء في مقدمة المجموع في معرض الحديث عن آداب الإفتاء "قال الصَيرميّ والخطيب: إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله، أو إن الصلاة لعبٌ، وشبه ذلك، فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القتل، بل يقول: إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان ... وإن سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض، يُسأل هذا القائل فإن قال أردت كذا بالجواب كذا"[4]. والشاهد في هذا أمران، الأول أنّ العامة يرجعون في هذه المسائل إلى العلماء، وإلى السلطان أو القاضي لإقامة الحد، والثاني هو تحرز العالم نفسه في الإجابة بما يوضح المسألة للسائل.
(2)
قضية كفر دون كفر هي قضية الفصل بين الأعمال المكفّرة بذاتها، المنصوص عليها في الشريعة، المتعلقة بالعقائد أساساً، أو ببعض الأعمال التي وضعها عدد من العلماء في مصافها مثل ترك الصلاة، وبين الأعمال التي هي من باب الكفر الأصفر التغليظيّ أو ما اشتبه بالكفر مما ليس بكفر يقينيّ لاحتياجه إلى ثبوت النية وتحقيق مناط الكفر الأكبر. فيختلط على الناس، كعادة الناس، أمر "الكفر" و"التكفير". أما الكفر فدرجتان، أصغر وأكبر، وتنزيلهما على العموم أو على المعين. وبناء عليه فالتكفير فنوعان، حق وباطل.
يختلف الحكم بالكفر على المعين عنه على الحكم به على العموم بالنسبة للعاميّ أو العالم. فالعالم الربانيّ قادر، بعد معرفة أحوال قائل الكفر أو فاعله، سواءً كان معيناً أو على العموم، أن يحكم بالتكفير أو عدمه في أي قسم من درجات الكفر بحق لا بباطل. أما العاميّ، فالأصل إنه ليس له أن يحكم بكفر أو ينزل التكفير على معين أو على العموم بتكفيرٍ في إلا في قسم واحد كما سنبيّن في الأقسام التالية، وإلا فحكمه باطل.
فأما القسم الأول، فهو الكفر الأكبر المخرج من الملة، يقع، فيقع التكفير به، بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، في حالة ترتيب الأحكام والقضاء، على يد مفتٍ أو قاض مختص. أو يقع إثباتاً خالياً من المترتبات ممن قدر عليه من العامة على العموم، في حالة المعلوم من الدين بالضرورة واشتهر بين الناس إنه كفر، لمن ظهر منه ذلك، فإن وقع هذا التكفير فهو حقٌ لا مراء فيه. ومثال ذلك أن يأتي رجل يدعى الإسلام فيقف في جمعٍ من الناس فيدعو إلى تبديل آيات القرآن، ويدعى إنه ليس صالحاً لهذا الزمن، وأنّ نصوصه تخرّب حياة الناس وتهدد مصالح الدنيا. فيقول له أحدهم "أتعي ما تقول؟ أسكران أنت؟ أنت تقول إنّ هذا القرآن مضر بنصوصه الثابتة؟" فيقول "نعم أعلم ذلك وأنا في كامل وعيي، ويجب تغيير هذه النصوص"، فيقال "قولك هذا كفرٌ محضٌ، وتعامل على هذا الأساس، حتى نرى حكم الله فيك على يد مفتٍ أو قاضٍ". فهذا لا يمتنع على العاميّ أن يثبت القول بالكفر للقائل المعين، لا تكفيره عينا، وعليه الدعوة لهجره وتحقيره، وإن لم يجب عيناً على أحدٍ منهم إقامة الحدّ عليه، إذ ذاك من مهمة قاضٍ أن يحكم عليه بالقتل، ويستوفى الشروط والموانع، إن ظهر ثمّة شروط وموانع. وما قلنا هو قولٌ واحد لا خلاف فيه.
وأمّا القسم الثاني، فهو الكفر الأكبر المخرج من الملة، في أمورٍ خفية أو أمور عقدية كالصفات أو المتواتر أو مواقع الإجماع، فإن وقع به التكفير من غير العالم، بل جزافاً دون علم، فهو كفر أكبر في ذاته لكن الحكم بالتكفير باطلٌ، لأنه وقع من عاميّ جاهل.
أمّا القسم الثالث، فهو الكفر الأكبر المخرج من الملة، يقع من المعين أو العموم، لكن لا يقع التكفير به من العالم، فيكون عدم التكفير من هؤلاء العلماء العملاء هو الباطل، ومن حكم بالكفر فيها من العلماء الربانيين هو على حق. وهذه هي صفة العمالة واتباع الأهواء والسلطان، كما نرى من متبعي السيسي كعلى جمعة والطيب وغيرهما. وهؤلاء "العلماء" قد يوافقوا الحكام والسلاطين فيما هو كفر فيكفروا بذلك، لكن إثبات هذا، مرة أخرى، لا يكون إلا على يد عالمٍ رباني متحقق بالعلم.
أما القسم الرابع، فما هو من أفعال الكفر الأصغر، أو من الذنوب التي أطلق عليها "كفراً في السنة النبوية للتغليظ، أو فيما اشتبه مناطه بما هو كفر أكبر، كمودة كافرٍ فيما ليس فيه نصرة ضد المسلمين، وما شابه مما أشرنا اليه في توضيح قولة "كفر دون كفر"، فإن التكفير هنا لا يقع إطلاقاً إلا على يد عالمٍ ربانيّ، إذ كلها أمور من الذنوب، صغيرها أو كبيرها، يعلم ذلك العالم لا يخفى عليه. فإن وقع تكفير من عاميّ جاهلٌ فهو باطلٌ بإطلاق كما قلنا. وتحديد مناطات الكفر الأصغر من الأكبر يحتاج إلى مفتٍ عالم ليرفعها من هذا القسم إلى القسم السابق. فإن لم يرفعها لمرتبة التكفير مع ثبوته، فهو على باطلٌ في عدم التكفير، كما ذكرنا مثلا في أنواع وأشكال الولاء، وإن كان له صور تختلف باختلاف الوقائع والحالات.
وأنا على يقين أن المسألة لا زالت تحتاج إلى تبسيط، إذ هي مسألة معقدة أساساً، لكن نسأل القارئ أن يصبر على تأمل الأقسام، والصبر على قراءة المادة وإعادة قراءتها لتحقق الفائدة. ومن أراد السلامة ترك أمر التكفير للعلماء برمته، إلا ما أشرنا اليه من عمومات عقدية لا غير.
والله من وراء القصد
د طارق عبد الحليم
10 يناير 2015 – 20 ربيع أول 1436
[1] مقدمة النووي للمجموع شرح المهذب، فصل آداب الفتوى، المسألة الثانية عشرة.
[2] الموافقات للشاطبيّ ج2 ص163
[3] "الفصام النكد وقضية التكفير" http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72827
[4] مقدمة النووي للمجموع شرح المهذب، فصل آداب الفتوى، المسألة التاسعة.