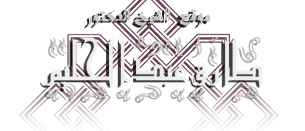الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد
(1) الفصام النكد
لا شك عندي في أنّ الكثير مما نحن فيه اليوم يعود إلى العلاقة بين العلماء والعامة. فالعلماء كانوا وسيظلون هم مصدر توجيه الأمة وقيادتها، وتصحيح مسارها إن انحرفت. هكذا جرى الحال طوال قرون المجد التي عاشتها هذه الأمة
ويشهد التاريخ أن هذه العلاقة كانت على الدوام في تغيرٍ بطيء وثابت في الهبوط والتدنّي. من حيث نرى أن تلك العلاقة كانت كأقوى ما تكون في القرون الهجرية الأولى، من ناحية الكيف، كما كانت نسبة العلماء إلى العامة عالية من ناحية الكمّ. وهو ما ساعد على الاحتفاظ بالهوية الإسلامية السنية، والقوة الإسلامية السنية.
ثم تغيرت المعادلة، زادت العامة، وقلت العلماء، فزاد انتشار الجهل في نواح عديدة من الدولة الإسلامية المترامية الأطراف حينها. وكان هذا الانتشار مختلف في كثافته، طردا وعكسا، يقل الجهل ويزيد العلماء كلما اقتربنا من مركز الإسلام العلميّ الجزيرة، ومن بعدها الشام ثم العراق، والعكس. وكما صحت هذه المعادلة مكاناً، صحت زماناً، فكلما مرّ الزمن، قلً العلماء وزاد الجهلاء تحقيقاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري"إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا".
وما نحن فيه اليوم، هو حقبة زمنية في هذا المسلسل التاريخي الحضاريّ، الذي لا تتمايز فيه أمة عن أمة، وهو، فيما نرى، مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه " لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ". وقد قصر كثير من العلماء دلالة هذا الحديث على اتباع هذه الأمة لغيرها في الابتداع والعادات الاجتماعية، لكننا نراه أليق في اتباع تلك الأمم في السنن الحضارية والتاريخية، التي منها تلك العادات والبدع.
وما تعانيه الأمة اليوم، من هذا المسلسل الحزين، قد استفحل واستشرى، وبانت معالمه واضحة لكلّ ناظرٍ، بعد ما أسموه الربيع العربي عامة، وأحداث الساحة الشامية العراقية خاصة، من حيث ندرة العلماء الربانيين من ناحية، واستشراء الجهل بنسبة لم تحدث في تاريخ الإسلام من قبل. ثم زاد الطين بلّة ذلك الخصام النكد بين العلماء الربانيين والعامة الدهماء بما كرسته تلك الجماعة الحرورية العوادية الساقطة، من فصام نكدٍ بين دهماء الأمة وعلمائها الأبرار، على ندرتهم.
ولمّا كان المرء مجبولاً على أن يتبع، فكان لابد لشياطين تلك الجماعة المارقة أن يجدوا بديلاً يتبعه أتباعهم، من حيث علموا إنهم لا ظهر لهم يتمسكون به، وهم أنفسهم ليسوا أهلاً للإتباع. فما كان منهم إلا أن لجئوا إلى ما تحبه النفس بعامة، وهو أن تتيع هواها. فصوروا للدهماء إنهم رؤوس بذاتهم، وأن دين الله ليس فيه عالم ولا متعلم، فما أنت عليه من هوى تراه حقاً هو الحق، ومن خالفك "فهم رجالٌ ونحن رجال"، ونحن "لا نعبد الرجال"، وصدقوا من حيث هم كاذبون. فمن الناس رجالٌ علماء، وأكثرهم رجال جهلاء، كما إننا لا نعبد الرجال، لكن لا نتخذ إلهنا هوانا " أفرأيت من اتخذ إلهه"، فهم في نأيهم عن "عبادة الرجال" عبدوا أنفسهم من حيث لا يشعرون.
ومن ثم، تضاعفت، بسبب تلك الجماعة المارقة، الهوة بين العلماء والدهماء، وزادت نسبة الجهل من حيث إن الجهال الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الآنف الذكر، لم يقتصروا على الرؤوس، بل أصبحت الدهماء ذاتها رؤوساً جهالاً، فعم الجهل وطمّ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
(2) الدهماء والتكفير
من هنا، نأخذ في الحديث عن مظاهر المصيبة التي أودت بنا إلى هذا القاع المنحط في العلاقة بين العلماء والدهماء، وسيطرة الدهماء والجهلة على الساحة العلمية – أو الجهلية إن شئت دقة الوصف. ونحن نحسب إنها قد ظهرت، وآتت أكلها في موضع "التكفير". وهو موضوع اشتبه على الكثير موقعه من العلم، من حيث هو أمرٌ عقديّ أو أمرٌ فقهيّ.
وهذه النقطة الأخيرة في غاية من الأهمية، إذ إن اعتبار موضوع "التكفير" أمرٌ عقديّ يجعله من الأمور التي تهم كلّ مسلم، بل هي من واجبات المسلم العقدية أن يحدد الكفر والإسلام، لا من حيث عمومياته، بل من حيث مناطاته وخصوصياته.
والحق إن موضوع "التكفير" فيه جانبٌ عقديّ، هو ما يتعلق بعموماته، وجانبٌ فقهي، وهو المتعلق بمناطاته وخصوصياته.
فأما الجانب العقديّ، فإن وضع حدّه يرجع للعلماء المعتبرين، الذين بينوا قواعد الإيمان وأصول التوحيد على مرّ القرون، والإيمان به، في عموماته، جزء من إيمان المرء وتوحيده. لكن مع وجوب أن يعرف المرء التوحيد أولاً حتى يعرف ضده ونواقضه. فالإيمان بكفر كلّ من ليس على دين الإسلام عقيدة واجبة، وأنّ المسلم قد ترتد بقولٍ أو فعلٍ، فليس نطق الشهادتين بحرز مطلق من الردة. وأن هناك نواقض قطعية للإسلام تُخرج المرء من دين الله، قد بينها العلماء، على العموم والاطلاق، لا على الخصوص والتعيين. ومن ذلك قول الله تعالى "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" وهو يعنى أنّ المسلم يجب أن يعتقد، إجمالاً، إن موالاة المشرك كفرٌ. أو قوله تعالى "إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ" فاطر 14، وهو ما يعنى أنّ الدعاء لغير الله شرك منصوص عليه، أو قوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكفرون" المائدة 44، وهو ما يعنى كفر المشرع من دون الله. ثم إنّ معرفة هذه الأمور، على عمومها، واجب على المسلم، وإن لم يكن الجهل بها مكفراً في ذاته، إلا إن وقع فيها بجهلٍ، فيكون فيه النظر الذي سنتحدث عنه لاحقاً. هذا هو القدر الذي يجب أن يكون جزءاً من عقيدة المسلم العاميّ، لا أكثر ولا أقل. فمن زاد فيه فقد تعدى حدود الله، ومن نقص فيه فقد افترى على الله.
أمّا الجانب الفقهي في مسألة "التكفير"، فهو حقٌ خالصٌ للعلماء، لا يصح أن يدخل فيه العامي من الدهماء بأي شكلٍ أو بأي قدرٍ كان. وهنا حدث الفصام النكد، واختلط العلم بالجهل، وصار ما صار مما يعرفه النظار.
والجانب الفقهي في هذه المسألة هو ما يتعلق بالمناطات والخصوص. وهو إنزال هذه العمومات العقدية التي ذكرنا أمثلة منها، على مناطاتها في الواقع، وهو مجال الفقه، الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضى الله عنهما أن يكون من أهله، فإذا اليوم كل دهماء الأرض، بحسب الحرورية العوادية، هم من أهله!
وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلّ حياته النبوية الشريفة بعد الرسالة، ثلاثة وعشرين عاما، في شرح وبيان هذا الجانب للصحابة رضى الله عنهم، وهم نقلوه نصّاً وفهما وتطبيقاً للتابعين ثم تابعيهم. ثلاثة وعشرون عاماً، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين عن ربه، تخصيص العمومات، وبيان المجملات، وتقييد المطلقات، في حياة الناس، بكل نواحيها. وقام من بعده علماء الأمة المجتهدين بمواصلة هذا الجهد، في كلّ باب من أبواب الحياة. هذا هو الفقه، الذي منه موضوع "تكفير" الخلق. وقد سُئل ابن عباس رضى الله عنهما عن آية المائدة، وسئل أبو مجلز لاحق بن حميد عنها من بعض قبيلته من بني سدوس، فالأصل أن يعود الناس لعلمائهم في مثل هذه الأمور، وقد بيّن بن عباس وأبي مجلز رضى الله عنهما مناط خاصاً وجهوا له النظر، فقال ابن عباس "ليس بالكفر الذي تذهبون اليه، أو ليس كفرا بالله وملائكته وكتبه .."، وقال أبو مجلز "فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا" الطبري، تحقيق أحمد شاكر المائدة44. والشاهد هنا أمران، أولهما أن القوم قد رجعوا لأهل العلم فيهم، حتى الإباضية من بني سدوس، ولم يسبوهم أو يرمونهم بالجهل أو تتعدون عليهم، كما تفعل الخوارج العوادية اليوم. والأمر الثاني، هو أنّ القوم قد قصدوا العلماء في تحقيق مناط محدد، فهمه عنهم ابن عباس وأبي مجلز رضى الله عنهما فردوا بالتخصيص، وهو ما يجب أن يفهمه دهماء العصر، إنّ هناك فرق بين العمومات وبين المناطات، وهنا يأتي دور الفقهاء والعلماء، لا الجهلة والدهماء.
ثم إن هذه الخصوصيات والمناطات لا يمكن أن يشملها كتابٌ أو تجتمع في قول عالم أيّا كان، بل هي تختلف باختلاف الأحوال والوقائع، يجب أن يرجع فيها السائل كلّ مرة تتبدل فيها الحال إلى عالم فقيه، خاصة إن تعلق الأمرُ باستحلال الدم وقتل النفس. وهو باب من أبواب الفقه في كافة كتب الفقه، وإن كان لا يكفي الرجوع لتلك الكتب بذاتها، إنها، وإن تناولت خصوصا في عموم، أو مقيدا في إطلاق، فهي لم تضف بعد المناط الخاص بذاته، فيبقى نظر العالم الفقيه واجباً لازما في مسائل الدماء والأعراض.
وهذا الذي ذكرنا، قد فصلنا بعض نقاطه من قبل في مقالات منشورة، حيث تناولنا على سبيل المثال موضوع الولاء والبراء في مقالين، وغير ذلك متناثر فيما دوّنا.
والله ولي التوفيق
د طارق عبد الحليم
7 يناير 2015 – 17 ربيع الأول 1436