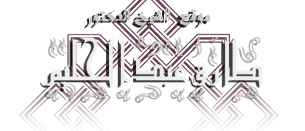الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد
سألني سائل حبيب عن حكم إقامة الحدود في المناطق "المحررة" في العراق أو في الشام؟ وهو سؤال وجيه يجب أن يبيّن فيه الحق، حسب ما تدل عليه الشريعة الغراء. فإن التنظيم الحروريّ قد أقام دعواه على اساس أنّه يقيم الحدود فيما هو تحت "خلافته"، بينما لا يقيمها غيره فيما امتلك من الأرض. والحق، أننا فد أجبنا هذا السؤال فس متناثرات من مقالاتنا السابقة، لكن لا باس من إفراده بالحديث لأهميته.
فأولا، يجب أن نفرق بين موضوع تطبيق الشريعة وتطبيق الحدود. وقد بيّنا، في مقال لنا من قبل، الفرق الشاسع بين إقامة "خلافة" تطبق شرع الله في الأرض، وبين ما تقوم به خلافة المسخ العوّادية، وهو الفرق بين الرحمة والعدلن وبين القسوة والظلم. لكننا هنا سنبين الفرق بين تطبيق شرع الله في الأرض وتنفيذ أحكام الحدود في محلة معينة.
فإن الشريعة الغراء بناء متكاملٌ يمهّد لحياة متكاملة الجوانب، تتعامل مع الإنسان في كليته، بحسناته وسيئاته، بأفضاله ومعاصيه، بما رفعه الله به وكرّمه فيه، وما وضعه وردّه به أسفل سافلين. الشريعة تتعامل مع هذا المخلوق الذي شرفه الله فوق الملائكة، لا مع عاصٍ يراد تقويمه، كما يتصور اصحاب الفهم الظاهريّ القاصر الحروريّ، ولا نحسبهم يفهمون هذا البعد على الإطلاق.
وهذا الفرق الشاسع يمثّل الإسلام في كليّتة وعمومه وشموله، لا تجزأته وتفتيته، فالشريعة، كما قال الشاطبيّ رحمه الله "ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر ببينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك الذى نظمت به حين استنبطت.
وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوى فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا حتى يستنطق فلا ينطق باليد وحدها ولا بالرجل وحدها ولا بالرأس وحده ولا باللسان وحده بل بجملته التى سمى بها إنسانا كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها لا من دليل منها أي دليل كان وإن ظهر لبادى الراى نطق ذلك الدليل فإنما هو توهمى لا حقيقى كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان لأنه محال، فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة، وشأن متبعى المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوا وأخذا أوليا وإن كان ثم ما يعارضه من كلى أو جزئى، فكأن العضو الواحد لا يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمتبعه متبع متشابه ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ ما شهد الله به ومن أصدق من الله قيلا"[1]
فالخطأ الذي يقع فيه الجاهل بالشريعة أنه يتعامل معها بشكلٍ جزئيّ مفتت، وهو ليس طريق الراسخين، بل طريق المبتدعين من أهل الأهواء، المتبعين للمتشابهات.
ومن ثم، فإنّ أصل المسألة التي يناقشها المناقشون، وهي "تطبيق الحدود" هو خطأ في أساسه، يصدر من أصحاب البدع والأهواء كالحرورية البغدادية. ولا يجب أن يخلط طالب العلم السنيّ تطبيق الشريعة، بتنفيذ الحدود، فشتان بينهما.
هذا من الجانب الأصوليّ.
أما من الجانب الفقهيّ، فإن الشريعة تشمل كلّ منحى من مناحي الحياة، ولا تقوم جزئياتها، فإيقاف العمل بالربا، ولإقامة اقتصاد إسلاميّ مستقل، وتنظيم الحياة المجتمعية على أسس الاجتماع الإسلاميّ، في العلاقات الأسرية وشؤون النساء بعامة، وغير ذلك من مناحي الحياة، لا يقوم إلا بفرض استكمال شروطها وانتفاء موانعها. كما حدث في أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه، حين أوقف العمل بحدّ السرقة، سواءً بقرار عام، أو بإيكاله إلى القضاة، فلا فرق، مراعاة لوجود المانع وهو شبهة الحاجة، والحدود تدرأ بالشبهات. واستكمال الشروط، ورفع الموانع ضروريّ قبل تطبيق أيّ حدٍّ من حدود الشريعة، وإلا كان اعتسافاً ومخالفة لمقصد الشارع، وهو كفّ الأذى وردع المعتدي، مع الحفاظ على العدل بأن يكون المحدود[2] مستحقاً بكمال شروط الحد وانتفاء موانع إقامته. بل العدل هنا مقدّم، بضمان استكمال شروط الحد وانتفاء موانع إقامته، لأنّ العدل ضروريّ كليّ، وقطع يدٍ واحدة لا يخرم أصلاً كلياً، بل الخطأ فيه بشعٌ لأنه عدوانٌ على حرمة الجسد أو النفس أو المال، وكلها كليات، لذلك جاء فيالقواعد الشرعية أنّ الحدود تدرأ بالشبهات. وذلك أصله أنّ اليقين لا ياُرفع بالشك، والبراءة يقين، والشك في الجرم لا يرفعه إلا إن كان يقيناً.
ومن ثم، ترى حكمة الشارع في إنزال القرآن، والشريعة، منجماً، يتعامل مع الواقع واحتياجاته حسب ما يتطور حاله. ولو أراد الله سبحانه لأنزل كلّ تفاصيل الأحكام مرى واحدة، وأخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة. وهو مخالف للفطرة والعقل، وللشرع جميعا.
وهنا لطيفة أود أن أشير اليها، تعين طالب العلم على الفهم المستقيم، وهي الفرق بين تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فإن انتفاء الموانع هنا، بأنواعها[3]، هي من قبيل العام، الذي تعتني به الولاة، ويجرى اعتباره قبل وقوع المعصية. أما تحقق الشروط فهو من قبيل الخاص، الذي يقع على الجاني مفرداً، ويكون تتبعه بعد وقوع الجناية.
ونحن هنا لا نقول بتدرج تطبيق الشريعة، إذ إن الجاهل بما نقصد يربط بين حديثنا هذا وبين من يطالبون بتدرج الشريعة. إنما نحن هنا، نقول بتطبيق الحدود التي توافرت شروطها وانتفت موانعها. فلو توافرت شروط كلّ الحدود وانتفت الموانع، لوجب تطبيقها كاملة. لكنّ دعونا نختبر هذه الفرضية في ظلّ الواقع الحاليّ.
الحرورية البغدادية تدعى أنّ الناس في ردة، وأنهم أخرجوهم منها بإعلان خلافة بن عواد، وأن غير المبايع كافرٌ، ومن ثم تدعوهم إلى التوبة والتطهر والنطق بالشهادتين. إذن هذا الواقع يصف جاهلية وردة عامة، ككفر قريش قبل عهد النبوة! أفلا يستدعي هذا الوصف أنّ هؤلاء "المرتدين" الذين أسلموا حديثاً، أن يتاح لهم الوقت لمعرفة أحكام دينهم الجديد، فترتفع الموانع التي يجب أن تراعيها "الخلافة" ليصح تطبيق الحدود. ومثال على ذلك، الصبي الذي صلبوه لإفطاره في رمضان. وهذا النظر مجمع عليه فيمن دخل في الإسلام حديثاً.
أما إذا كانت الحرورية العوّادية، تعتبر الناس مسلمين، وأن البيئة التي يعيشونها إسلامية، ارتفعت فيها موانع تطبيق الحدود، وأقيمت فيها الشريعة بتمامها، فيم إذن وثائق الاستتابة التي يوزعونها على الناس؟ وفيم التطهر والنطق بالشهادة؟ هذا ما نسميه "حيص بيص"!
ثم إنّ الحدود، والتي عرّفها العلماء، كالكاساني، بسبعة، حد الزنا، القذف، السرقة، حد قطع الطريق، شرب الخمر؛ البغي، الردة، إن أفردناها عن الشريعة، وخصصناها بأولية خاصة في التطبيق، من منطلق العقلية الحرورية المحدودة الانتقامية، التي ترى العقاب قبل الإمهال والإنذار، يجب أن ترتفع موانعها كما قلنا، ومن موانعها مثل دفع الضرر المتوقع.
ومثال ذلك حدّ المرأة الحامل أو النفساء، إذ يُتوقع موتها أو موت جنينها، وهذا مخالف لمقصد الشارع، في مجرد الزجر، لا القتل، كما جاء في حيث مسلم عن عليّ رضي الله عنه "قال: "إنَّ أمةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدﻫا، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أحسنت اتركها حتى تماثل". وهذا مثال على منهج نظر النبوة في التعامل مع المسلمين، وما أصبح علي من الراشدين إلا باستيعاب هذا البعد المنهجيّ.
ثم إنه يجب العلم بأنه هناك فرق بين إسقاط الحدّ أو تأجيله، وما ذكرنا هو من باب تأجيله، وكما ذكر بن تيمية عن تأجيل الحدود في دار الحرب، لضرر تقوية الكفار بردة المحدود، وهروبه اليهم خوفاً، قال "إن تأخير إقامة الحد على الجاني لمصلحة راجحة للمسلمين وهو خوف ارتداده ولحوقه بالكفار مما يضعف المسلمين ويقوي غيرهم ... فتأخيره للمصلحة العامة أولى". أمّا إسقاط الحدود فلا يجوز، بل هو معصية عظيمة، وقد ورد عن سول الله صلى الله عليه وسلم "لا تقطع الأيدي في الغزو"[4].
كذلك يجب أن تصح نية الوالي في إقامتها لصالح العباد، يقول بن تيمية "فهكذا شرعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوإلى في إقامتها، فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهى عن المنكرات، بجلب المنفعة لهم، ودفع المضرة عنهم، وابتغي بذلك وجه الله ـ تعالى ـ وطاعة أمره، ألان الله له القلوب، وتيسرت له أسباب الخير، وكفاه العقوبة البشرية، وقد يرضي المحدود، إذا أقام عليه الحد. وأما إذا كان غرضه العلو عليهم، وإقامة رياسته ليعظموه، أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال، انعكس عليه مقصوده"[5].
والواجب هنا هو اعتبار دار الإسلام ودار الحرب، وحدودهما، وشروطهما. فإننا نرى أنّ دار الإسلام التي تنطبق عليها شروطها بشكل صحيح غير معتسف، لم تقم بعد، لا في الشام ولا في العراق. وقد بيّنا هذا بإسهاب في بحثنا عن "قيام دولة الإسلام"[6]، فلا معنى للإعادة.
ومن ثمّ، فإنّه بناء على ما ذكرنا، فإن إقامة الحدود اليوم في المناطق "المحررة"، والتي ليست هي "دار إسلام" بالمعنى الفقهيّ، بل هي محاطة من جميع أقطارها بدول وكيانات كفرية، بل مخترقة في داخلها بكيانات كفرية، وفي صراع دائم متواصل مع تلك الكيانات، ولا يفصل "حدودها" عن تلك الكيانات الكفرية إلا حواجز خرسانية متنقلة، توضع وترفع حسب الحاجة، مما يجعل فرار المحدود أمر في غاية السهولة أولاً، ثم عدم رفع الموانع الشرعية بنشر العلم الكافي ثانياً، يجعلنا نرى تأخير تلك الحدود، بشكل قاطع، وأنّ إقامتها في تلك المناطق ممكن شرعاً، فقد لا يؤدى إلا إلى إضعاف الكيانات المسلمة، إلا إن كان الأمر يتعلق بالدماء، فهذا لا يحلّ تأجيله كالقتل العمد.
إلا إننا نؤكد كذلك أنّ هذا التأجيل يجب أن يكون بناء على صحة نية القائمين على تلك المناطق في منع الضرر، لا لمجرد الحصول على الدعم او التأييد، كما أشار بن تيمية "فإن إقامة الحد من العبادات، كالجهاد في سبيل الله. فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده، فيكون الوإلى شديدًا في إقامة الحد؛ لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات، لا شفاء غيظه، وإرادة العلو على الخلق"[7]، اي عكس ما ذكرنا عنه سابقاً فيمن يطبق الحدود رغبة في السلطان.
[1] الاعتصام للشاطبيّ ج1 ص244 وبعدها
[2] أو "المُحَدّ" أي من يستحق إقامة الحدّ عليه
[3] راجع "أصول الفقه" محمد أبو زهرة، طبعة دار الفكر العربي، ص58
[4] الترمذي وقال حيث غريب
[5] مجموع الفتاوى، مجلد 28، ص 330
[6] http://www.tariqabdelhaleem.net/new/ArticalList-137
[7] مجموع الفتاوى ج28، ص 329 وبعدها