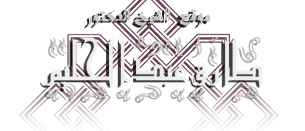الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد
تحدثنا في بحث "إقامة دولة الإسلام..بين الواقع والأوهام"(1) بتفصيل واسع، في اثني عشر مقالاً، عن الخلافة ومركباتها، وشروطها، ومعنى أهل الحلّ والعقد، والتمكين، وسائر ما يتعلق بالخلافة العظمى، بما يناسب واقعنا الحاليّ، خاصة فيا يتعلق بلاد العراق والشام. والحق، أننا قد أهملنا نقطة نتداركها في هذا المقال، قدر المستطاع. وهي تدور حول "الإمارة الإسلامية" وعلاقتها بالخلافة، خاصة في واقعنا المعاصر.
والأصل أنّ الإمارة فرع انبتّ عن الخلافة، لا يجب أن تستقل بذاتها إلا في ظروف خاصة طارئة. فقد وُلدت الخلافة يوم توُفي حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولدت بعد ذلك الولايات، حين ولّى الخلفاء ولاتهم على العراق والشام واليمن، ثم خراسان وما وراء السند، ومصر وشمال افريقية. كانت تلك كلها ولايات، تصغر وتكبر مع اتساع رقعة الدولة، فيجمع بين بعضها أو يقسّم بعضها. وكان عمل الوالى هو إدارة شؤون ولايته وتسيير نظامها وجباية خراجها، وإدارة اعمالها، تماما كمهمة حكام الولايات في النظم الفيدرالية، ومرجعه في ذلك الخليفة أو أمير المؤمنين.
أمّا تعبير الإمارة، والأمير، فقد ظهر أولاً في بعض حديث منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في "إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمّروا أحدكم"، وهو، وإن كان موقوفا على بن مسعود، فله شواهد، وهو كاف للدلالة على ما نقصد اليه منه، وهو استخدام لفظ الأمير، سواء استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بن مسعود رضى الله عنه. وقد استخدم بشكلٍ يوحى أنه محدود بمهمة خاصة، أو بعمل محددٍ ليتم هذا العمل على وجه التمام، فكل عمل ليس له رأسٌ خرج خداجاً، إن خرج إطلاقاً!
ثم ظهر تعبير الأمير في لقب "أمير المؤمنين"، على عهد عمر رضى الله عنه، وكانت الإمارة، إن أُطلقت، تعنى إمارة المؤمنين، فهي الإمارة العامة أو العظمى. كما لم يكن من المعروف إطلاق لفظ الأمير أو الوالي إلا على من يوليه الخليفة عملاً خاصاً، وهي الإمارة الصغرى أو الخاصة، كإمارة الحج أو السفر، وكثيراً ما تتعلق بالمهام العسكرية كذلك.
ثم بدأ ظهور "الإمارة" أو "الدولة" استقلالا بعد أن اتسعت رقعة الخلافة الإسلامية، وحين بدأ ضعف الخلفاء يؤدى إلى تعذر السيطرة على أطرافها، كما حدث في الدولة السامانية والطاهرية وغيرهما، مع أن الكثير منها كان خاضعا لبيعة "خليفة". والحق أن المؤرخين قد خلطوا في استخدام مصطلح "الوالي" و"الأمير"، وتعاملوا معها على معناهما اللغوي الذي يتقاربا فيه، بدلاً من معناهما الاصطلاحيّ الذي يتباعد فيه مفهومهما.
وما يهمنا هنا هو أن نقرر أمرين، أولهما أنّ الوضع القائم اليوم هو محاولة لالتياث الظلم التي صارت اليها أوضاع المسلمين، بعد سقوط الخلافة وغياب الدولة المركزية وانعدام الإمامة العظمي. ومن ثمً، فإننا نبحث، كما بيّنا في بحثنا المُشار اليه، في وضع جديد على أرض الواقع، لم يعد افتراضيا كما كان على عهد الإمام الجويني رحمه الله.
وثانيهما، أنّ الغرض من الإمارة، أو الولاية العامة إن شئت، هو مصغّرٌ عن الغرض من الخلافة، وهو جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم، وجمع شملهم والقيام بأمرهم في حماية الدين والدنيا. ومن ثمّ فإن الشروط الواجب توفرها في إقامة "إمارة" أو "ولاية" عامة هي ذاتها التي يجب مراعاتها في إقامة الخلافة، في هذا الوضع الجديد الطارئ، مع فارق رئيس وهو حدود البيعة للأمير أو الوالي. إذ بيعة "أمير المؤمنين" بيعة كبرى لا رجوع فيها إلا إن كفر وارتدّ، أو أظهر عداءً للدين وأهله لا يُحتمل..
فإنه إن تتبعنا الأحداث التاريخية، وجدنا أننا نتحدث عن ثلاثة أنواع للإمارة، 1) إمارة عظمى، وهي الخلافة، و2) إمارة عامة وهي ولاية أمير على إمارة، و3) إمارة خاصة وهي إمارة أمير على مهمة محددة.
فالنوع الأول، وهو الإمارة العظمي، هي إمارة المؤمنين، أو الخلافة، وقد تحدثنا عنها في بحثنا المشار اليه. والإمارة العامة، هي ما يثبت به حقوق تشبه حقوق من يعينه الخليفة، وإن لم يكن معيناً بخليفة لعدمه في الساعة.
أما النوع الثاني من الإمارة، الإمارة العامة، فهو ما يمكن تصوره، وتحقق شروط. وفي ظروفنا الحالية، نتيجة لفقدان الخليفة، فإنّ تعيين الأمير أو الوالي، ولاية عامة، يجب أن يخضع لنفس شروط تعيين الخليفة أو أمير المؤمنين، إلا ما كان من شرط النسب، من حيث اختيار أهل الحلّ والعقد له، ومن حيث صفات أهل والعقد في الوسط الذي يجتمع عليه المسلمون في تلك النواحي، لحما مقصد الولاية. وعلى رأس هذه الشروط، المشورة، واجتماع الكلمة على الأمير أو الوالي أو القائد، سمه ما شئت، وإلا فقدت البيعة الغرض منها أصالة، وهو جمع الكلمة لتحقيق هدف مشروع. كذلك، لا يصح أن يُفرض أحدٌ، أو أن يَفرض أحدٌ نفسه، على الجماعة المسلمة، لما في ذلك من سلب لحقهم الأصيل في اختيار من يقودهم. فإذا لم يوافق أحدٌ على بيعة أميرٍ، ولو في الإمارة العامة، فهو بالخيار أن يترك سالماً لا حرج عليه، وإلا عدنا إلى مفهوم حكم الأغلبية، وفرضه على الناس، من زاوية جديدة!
هذا اللون من الإمارة العامة أو الولاية العامة، لا حرج فيه في أيامنا هذه، بل هو واجبٌ أينما تحققت شروطه، ولا يجب انتظار تحقق شروط الإمامة العظمى، ووجودها الحقيقي على الأرض، للقيام بواجبات الوقت، من خلال مثل تلك الإمارة.
أمّا النوع الثالث، وهو الإمارة الخاصة، فهي مبايعة أمير على هدف خاص، بيعة خاصة مؤقتة، أمّا البيعات الصغرى كلّها، فهي بيعات على الأمر الخاص الذي بايع عليه الناس، كالحجّ أو السفر أو قتال طائفة معينة، أو غير ذلك من الأمور المحدودة زماناً ومكاناً وموضوعاً.
و إعلان "إمارة" عامة يدخل فيه اشتراطات أخرى، منها التحيّز ووجود الأرض التي يمكّن للأمير فيها، بشكل شبه ثابت، لا يتبدل يومياً، وإلا كانت تلك مرحلة جهادٍ، وإمارة خاصة لا إمارة عامة.
وواجب الأمير في إمارة عامة، يشبه واجب الخليفة كما ذكرنا، أمّا في الإمارة الخاصة، كإمارة جماعة إسلامية، فإنها ترتبط بأداء مهمات الجماعة الإسلامية، من دفع صائل، او بيان حقٍ أو نشر سنة أو نصرة مظلوم، أو غير ذلك مما يجتمع عليه المجتمعون، من أغراض دعوية أو عسكرية أو اجتماعية .
ومن هنا، يجب التفرقة بين الإمارة الخاصة، وبين إعلان "إمارة" متحيزة. والخلط بينهما هو مصيبة لا تقل عن داهية تنظيم بن عواد. فالأمير المُبايع لا يُشترط له تمكين إلا في حدود مهمته، زمانا ومكانا وموضوعا. بل تحقيق الهدف، في حدوده التي يقدر عليها، هو منتهى غايته، ونهاية قدرته.
وهذا المقصد الشرعيّ واجب عينيّ على القادرين عليه، سواءً أعلنوا إمارة بأمير، أو غفارة بغفير، لا يهم مسمياته، بل تحقيق القصد هنا هو ما يجب التركيز عليه. وقد رأينا الكثير من الجماعات الجهادية السنية تقوم بهذا العمل، ما استطاعت. ولكلٍّ منها "أميرها"، كما تعارف عليه المحدثون.
والمصيبة الداهية هي الخلط بين أنواع الإمارات، العظمى والعامة والخاصة، كما حدث مع تنظيم إبراهيم عواد، وفتنته الواقعة. إذ تحوّل تنظيم بن عواد من إمارة خاصة لجماعة أو تنظيم، إلى إمارة عامة في العراق، ثم إلى إمارة عظمى في العراق والشام، في غضون سنة، دون استشارة أو بيعة عامة أو أهل حلّ وعقد معتبرين، أو أرض ممكن فيها تمكينا حقيقياً. والحق، أن وضعهم يقع بين الإمارتين العامة والخاصة. ولا يصل حتى إلى الإمارة العامة لفقد شروطها من بيعة واستشارة وأرض مُمَكَّن فيها على التحقيق. وإمارة طالبان كانت، ولمدة خمس سنواتٍ، ممكنة في كلّ أرضها إقتصاديا وعسكريا وسياسيا واجتماعياً، ومبايعة من كلّ مواطنيها. وهم، من فقههم، وفقه القاعدة هناك، لم يعلنوا خلافة، لعلمهم بعدم القدرة على توفيتها حقها، من كون الملا عمر جُنّة لكافة المسلمين في أراضى المسلمين، ولا نقول في أنحاء العالم، حتى لا نضع شرطاً مُعجّزاً ليس بشرط في السنة.
ومن ثم، فإننا نوجّه كتائب وجبهات المجاهدين السنة، في العراق والشام، إلى فقه هذه المسائل، وتحري شروط الإمارات الثلاث، وعدم الخلط بينها، حتى لا نخالف العوّاديّة إلى ما ننهاهم عنه، وهو التسرع في إعلان كيانات دون تحقق شروطها. والواجب أن يستمر العمل الجهاديّ ضد الروافض والنصيرية، بموجب البيعات الخاصة على القتال. وحين تتحقق شروط البيعة للإمارة العامة، ليست العظمي، فتلك وراء ما يمكن أن يحققه المسلمون في هذا الوقت، فإنه يمكن أن تكون هناك ولاية شرعية أو إمارة شرعية عامة إن شئت، في حدود الأرض المُمَكَّن لهم فيها.
وبعد، فإن تجمع تلك الكتائب والجبهات تحت راية واحدة أمرٌ مطلوبٌ ببيعات قتال خاصة، حتى يتم لها التمكين وإقامة إمارة عامة بإذن الله، تتلوها، حين يحين حينها وتتحقق شروطها حقيقة لا توهماً، خلافة على منهاج النبوة، لا على منهاج الخوارج أو المرجئة.
د طارق عبد الحليم
4 شوال 1435 – 1 أغسطس2014
[1] هذا المقال يعد تكملة لسلسلة "قيام دولة الإسلام بين الواقع والأوهام" http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72693