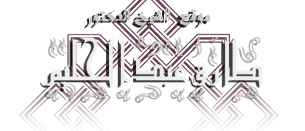الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد
(1)
منذ أن قرأت كتاب شيخ الاسلام بن تيمية الشهير "رفع الملام عن الإئمة الأعلام"، الذي يشرح فيه أسباب اختلاف أئمة الفقه في الأحكام الشرعية، والفكر يدور حول مسألة إختلاف النظر والاستدلال على الأحكام الشرعية من ناحية، وعلى استنباط الفتاوى من أحكامها التفصيلية أو قواعدها الكلية، من ناحية أخرى.
والاختلاف عادة يشير إلى أحد أمرين، اختلاف في مصدر الدليل، واختلاف في تأويل الدليل. وقد أتى بن تيمية بكثير من النوع الأول. كما تعرض إلى النوع الثاني في بعض أمورٍ تتعلق بمفهوم الخطاب، وركّز على التفرقة بين إثبات التحريم وإثبات الوعيد.
لكنّ الحديث عن الاختلاف في النتيجة لا يغطى ما نقصد اليه هنا، إذ نحن نتحدث هنا عمّا يسبق الاختلاف، أي عن طريق النظر في الأدلة ابتداءً، سواءً كان منها ما هو معروفٌ أو ما هو مجهول. وقد يلتقى الوجهان، ويكون طريق النظر مؤدياً إلى الاختلاف في النتيجة، لكنه ليس اتفاقا متطابقاً بأي حالٍ، أي أنّ كلّ اختلاف في طريق النظر يؤدى إلى اختلاف في الاستدلال، لكن ليس كلّ اختلاف في الاستدلال يرجع إلى اختلاف في طريق النظر.
وكمثالٍ سريع على ما نقول، فقد يختلف فقيهان في حرمة ربا الفضل، لعدم وصول الحديث لأحدهما، أو لشبهة في تأويله، لكنهما يتفقان على أنّ الحديث إن صحّ ودلّ على المسألة، وجب الرجوع اليه بلا خلاف، لعدم إمكانية معارضة النصّ الصحيح الصريح. فهنا أصل النظر، وهو "عدم إمكانية معارضة النصّ الصحيح الصريح" متفق عليه، لكنّ الدليل ناقصٌ عند أحدهما، فهما متفقان من جهة ومختلفان من جهة أخرى.
وما نقصد اليه من منهج النظر والاستدلال هنا، يقع أساساً على ما صنفته العلماء في باب "الاجتهاد". إذ إن النظر في مسائل النص والاجماع لا مجال فيها لكثير استنباط، إلا في الأبواب التي ذكر بن تيمية في كتابه العظيم، أو مثلها. أما أبواب الاستدلال الاجتهاديّ فهي التي تتطلب، حسبما نرى، طريقٌ واضحٌ واحدٌ مؤسس على بدهيات عقلية وشرعية لا يكون عليها اختلاف.
ويسأل سائل، إنه يلزم من قولك هذا أن المسائل الاجتهادية هي التي يكون فيها اتفاق النظر، بينما المسائل المبنية على النصوص هي التي يكون فيها مواطن الخلاف، بينما العكس هو المعروف؟ هذا خلاف ما عليه علماء الشريعة على مرّ العصور.
قلنا، رويدك، فإن المسألة ليست بهذه البساطة. فقد عرفنا كيف يكون الاختلاف في المسائل التي ثبتت فيها نصوص واضحة صريحة، لكن المشكلة في المسائل الاجتهادية. وهي يقع فيها خلافٌ كذلك بلا بد. لكن هناك مستويات للنظر في هذه المسائل، منها أساس النظر في الأدلة، استدلالاً أو استنباطا، ثم إلحاق المسائل تلك بالقواعد العقلية أو الشرعية، المتفق عليها في الجملة، إلى أيّ منها أقرب وأدق صلة، ثم تنزيلها جزئياً أو كلياً، على تلك القواعد، فقد تتقاسم قاعدتان مسألة واحدة في النظر، ثم تحقيق مناط المسألة، وهو آخر تلك المستويات، أو المراحل. فالأول منها، هو ما نعنيه في حديثنا هذا، وهو ما لا يجب أن يختلف فيه العلماء، بل البشر الأسوياء. أما الباقي فهو ما يكون سبباً في اختلاف النتيجة أو الحكم أو الفتوى حسب الحال.
ويجدر هنا الإشارة إلى الفرق الذي نراه بين تعبيريّ الاستدلال والاستنباط، فإن بينهما عموم وخصوص. فالاستدلال من الدليل، وهو إما ما يستدل به على غرضٍ، أيّا كان هذا الذي يستدل به، أو هو اسمٌ لمن يدل على الشئ، كما يقال فلان دليلنا، أي هادينا إلى بغيتنا. ومن هنا فإنه يقال أن المجتهد "دليل العاميّ".
أما الاستنباط فهو عملية أخصّ من الاستدلال بمعناه الأوسع. إذ تأتي من مصدر "نبط". جاء في لسان العرب - حرف الباء "والاستنباط : الاستخراج . واستنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه . قال الله عز وجل "لعلمه الذين يستنبطونه منهم"النساء 83 ، قال الزجاج معنى يستنبطونه في اللغة يستخرجونه، وأصله من النبط وهو الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر" وفي قاموس المعاني "اِسْتِخْراجُها بِفَهْمٍ واجْتِهادٍ". فاستنباط أليق في الاستعمال عند الحديث في أصول النظر المختصة بالاجتهاديات، الاستدلال أليق في الاستعمال حين الحديث عن أصول النظر بعامة.
يتبع إن شاء الله
د طارق عبد الحليم
12 يونيو 2014 – 14 شعبان 1435