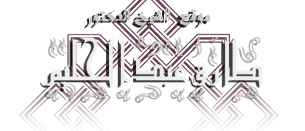الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أعود مرة أخرى إلى حزب التحرير، على مَضَضٍ منى، إذ لا أجدُ جديداً قدّمه هذا الحزب، حتى الآن، ما يستحق الردّ عليه، بل هو ذات ما قدّم النّبهانيّ منذ أكثر من نصف قرن من الزمان. كما أنه قد لفت بعض الإخوة نظرى إلى موقعٍ لهذا الحزب، يرتاده متعصبوه، قد علّق فيه البعض بتعليقات أحسب أنها لم تأتِ إلا من "هواة علمٍ" لا أكثر. هذا إلى جانب تسافُلٍ في بعض الحديث، وقلة أدب لا تخرج إلا من صغارٍ يجب على العاقل تجنّبهم ابتداءً. وكنا قد أزْمعنا الغَضّ عن هؤلاء إذ نحن مأمورون بإهمال أهل البدع في الإعتقاد والعمل، لكن، فزِعَ إليّ عدد من الإخوة أنني أسديت جميلاً لهؤلاء بما كتبت عنهم، كأني حَرّكت بركة راكدة، كما أن بعض شبابنا ليس له قدرة على الجدال والمَراء الذي يمتاز به منتسبو هذا الحزب، بصفته حزباً يقوم على مناهج جدلية أقرب لعلم الكلام، وإن عابَ النبهانيّ على علم الكلام بحق، (راجع حديثه عن المتكلمين في كتاب الشخصية الإسلامية 1 ص 49).
وقبل أن أبدأ حديثى، أودّ أن أبيّن أنّى لا أجادل ولا أمارى، ولا أردّ على تعقيباتٍ ولا تعليقاتٍ، ولكن أكشف للقارئ العاديّ حقائق ومواقف، كما أمَرنا الله أن نُبيّن للناس الحقّ ولا نكتُمه. وسأكتفى بهذا المقال في هذا الأمر، حتى أعطي الأمر حَجمه الذي يحتله على الساحة، متناسباً مع حجم الحزب نفسه، ثم أحيل القارئ للكتب التي دُّونت في بحث وتحليل عقيدة الحزب[1]، إذ لا داعٍ لصرفِ الأوقات فيما قام به الغير إبتداء.
ونحن هنا ندوّن مقالاً، ولا نقصدُ إلى إخراج كتابٍ في الموضوع، إذ هناك العديد من الكتب التى استفاضت فيما لحزب التحرير وفيما عليه من قبل، وقد استفدت منها في هذا المقال. ولا أظن أنّ هذا المقال، بل ولا مجلداتٍ مثله سيغيّر من اتجاه واحدٍ ممن التزم بهذا الفكر، فهى طبيعة التحزب، التقليد الذي يظهر من الخارج أنه تَحرُرٌ منه. وإنما القصد هنا هو بيان بعض ما على الحزب من الناحية العقدية والحركية، أما بيان ما للحزب، فندعه لله يجازى به مؤسسه وأتباعه بما يراه سبحانه.
من ثمّ، فسنلقى نظرات عَجْلى على بعض أمور في شؤون الدعوة، الحركية والعقدية، كما يراها حزب التحرير، وفقاً للرؤية التي طرحها النبهاني منذ ستين عاماً، من واقع ما كتب.
مشاكل حركية عند حزب التحرير:
النبهانيّ والهدف السياسيّ:
من المهم أن نقرر هنا أنّ حزب التحرير هو النبهانيّ، والنبهانيّ هو حزب التحرير. فشبابه لم يخرجوا على إجتهاداته إلا في مواضع أقل من القليل، فكانوا بذلك أشدّ تقليداً لزعيمهم من تقليد الإخوان لحسن البنا. وهو أمرٌ طبيعيّ إن عرفنا الفرق بين شخصيتيّ النبهانيّ وحسن البنا. فالبنا رجل تربية بالأساس، عمل على صَقل الخُلق، وسعى إلى إقامة الإسلام في النفوس قبل إقامته على الأرض، بينما النبهانيّ رجل فكر وسياسة، يسعى إلى إقامة دولة على الأرض، تتولى هي من بعد تطبيق الإسلام متكاملاً، ولا محلّ للتربية في دعوته. وقد أخفق كلاهما في تحقيق ما وضعوه هدفاً لهما. وما أرى ذلك إلا للإنحراف العقديّ الذى صاحب دعوتهما. ثم لا ننسى أن لنشأة النبهانيّ أثرٌ في هذا التطرف في الحقل السياسيّ الذي صاحب دعوته، وما جرى من فقد فلسطين كدولة، ومن تشريده وأهله منها، لعن الله اليهود، ثم توجهاته القومية العربية، ومصاحبته للقوميين العرب في فترات من حياته، مما جعل السياسة هي العمود الفقريّ لفكره ثم لدعوته ولحزبه.
يقول النبهاني في التكتل الحزبيّ "مع أن الأمم لا تكون بالأخلاق، وإنما تكون بالعقائد التي تعتنقها، وبالأفكار التي تحملها، وبالأنظمة التي تطبقها" ص18، ويقول "أما الدعوة التي تحملها جماعة أو كتلة في أعمالٌ تتعلق بالفكر ولا تتعلق بالقيام بأعمال أخرى، ولذلك تأخذ الناحية الفكرية لا الناحية العملية فتقوم بما يفرضه عليه الشرع (يقصد العمل لإقامة الدولة دون النظر إلى الأخلاقيات، ولذلك كان منهم ممن أعرف شخصياً من يشاهد الأفلام الإباحية ويدخن وهو عضو فاعلٌ في الحزب عام 1968) حتى توجد الدولة الإسلامية ثم تبدأ الناحية العملية في الدولة"، حتى يقول "ولذلك يجب أن تكون الكتلة التي تحمل الدعوة الإسلامية كتلة سياسية ولا يجوز أن تكون كتلة روحية ولا كتلة خلقية، ولا كتلة عملية، ولا كتلة تعليمية ولا شئ من هذا، ولا ما يشبهه، بل يجب أن تكون كتلة سياسية، ومن هنا كان حزب التحرير - وهو حزب إسلامي - حزبا سياسياً يشتغل بالسياسة ويعمل لأن يثقف الأمة ثقافة إسلامية تبرز فيها الناحية السياسية". ثم إذا به يقول في الهدف التحريريّ "... وإنما هو في قيام دولة تستأنف الحياة الإسلامية عن عقيدة، وتطبق الإسلام في المجتمع، بعد أن يكون متغلغلاً في النفوس متمكنا من العقول .." مفاهيم حزب التحرير 72. فهو يدعو في ناحية أن لا يكون التكتل خلقياً أو تعليمياً، بل يجب أن يكون سياسياً فقط، ثم يعود إلى قول أنّ قيام الدولة يكون "..بعد أن يكون متغلغلاً في النفوس متمكنا من العقول"!. وهو تناقض واضحٌ في الهدف وفي سبيل تحقيقه، فمن سعى لقيام الدولة دون الإلتفات إلى الخلق، فما الذي يجعل الإسلام متغلغلاً في النفوس إذن؟ لكن هذا أمرٌ يخفى على أتباع الأحزاب والجماعات، إذ إنهم يرون المؤسس الأول كأنه نبيّ لا يخطئ، ويجب تأويل كلامه والالتفاف به ليكون حقاً وإن كان باطلاً.
تبنى الدعوة إلى الخلافة كفكرة محورية:
والنبهانيّ، ومن ورائه حزب التحرير، يجعل الفكرة السياسية هي المحور في الدعوة الإسلامية، كما رأينا فيما نقلنا عنه. ولهذا تعتبر فكرة إقامة الخلافة الإسلامية، أو إعادتها إلى الحياة بتعبيرٍ أدق، هي محور دعوتهم، وإن توسلوا بالحديث عن أمور غيرها، إذ تأبى الفطرة العقلية والروحية أن تتخذ من منهج النبهانيّ أساساً لدعوة إلهية شاملة.
ومن هنا وجدنا عند مُنَظّرِ الحزب الأول، والأوحد، التوسع الذي يتجاوز إلى حدّ التوله بكتابة دساتيرٍ وأشكالٍ للحكم، وهم لم يتمكنوا حتى من الحصول على ترخيصٍ لإقامة الحزب في بلدٍ واحد بعد! وهو أمر يدعو للحسرة أكثر منه إلى أيّ شئ آخر.
وقل يقول البعض أنّ فكرة إقامة الدولة الإسلامية، هي فكرة عامة مشتركة بين غالب التكتلات الإسلامية التي ظهرت على الساحة السياسية والدعوية بعد سقوط الخلافة، والتي اتخذت من الإسلام منهجاً عاماً للحياة، سواءً دعاة أهل السنة والجماعة، أو الإخوان أو حزب التحرير، فما العيب على حزب التحرير إذا من الدعوة إلى الخلافة؟ أليست هذه الدعوة هي أساس محوريّ يمكّن للمسلمين حياة كريمة ويؤسس لنهضة هم أصحابها، وولاة أمرها؟
والحق أن هذا التساؤل يكشف عن عدم فهم لدعوة حزب التحرير أولاً، وللدعوة الإسلامية ثانياً. فإنه يجب في البدء أن نقرر أنّ مهمة المسلم في الحياة ليست إقامة دولة إسلامية، بل لم تكن هذه الدعوة جزءٌ من دعوة الرسل عليهم صلوات الله. إن دعوة الرسل كلها كانت لتوجيه البشر إلى عبادة الله سبحانه، والإقرار بألوهيته وحاكميته، بعد إقرارهم بربوبيته. والآيات القرآنية متواترة في هذا المعنى "قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره"، "وأن الله ربي وربكم فاعبدوه". فعبادة الله إذن، بمعنى طاعته والإلتزام بأمره هي هدف الرسالات كلها. وهذا الهدف منه ما يتحقق في حياة الأفراد بطريق فرديّ، كالصلاة والصوم وغض البصر والحجاب، ومنه ما يتحقق في حياة الأفراد بشكلٍ جماعيّ يستلزم إقامة حكومة مركزية تقوم على بناء صرحه وممارسة شرائعه، وإن كان كلا الجانبين متداخلان على مستوٍ ما، إذ من التكاليف الفردية ما يستدعى سلطة الدولة كذلك، كنشر العلم والتعليم، وتهيئة المناخ للخلق الحسن بتهيئة ظروفه عن طريق الإعلام النظيف وغيره. ومن هنا فإن قصر الدعوة هلى الجانب السياسيّ، بهذه الصرامة التي ظهرت في تعبير النبهانيّ "ولا يجوز أن تكون كتلة روحية ولا كتلة خلقية، ولا كتلة عملية، ولا كتلة تعليمية ولا شئ من هذا، ولا ما يشبهه، بل يجب أن تكون كتلة سياسية" هي مضادة لطبيعة الدعوة الإسلامية الشاملة التي تدعو الناس إلى العبادة والطاعة في القول والعمل، ومن ثم يفتح الله عليهم أبواب السيطرة والقوة والغلبة، ثم الحكم وإقامة الخلافة. وقصارى ما يمكن أن تصنف مثل تلك الدعوة التحريرية على أنها دعوة مرحلية متخصصة، ترمى إلى التثقيف السياسيّ لدى أفراد الأمة، لا غير. أما أن تكون دعوة شاملة يتبناها أفراد مجتمعٍ بأسره، فهذا لا يصلح بشكلٍ من الأشكال، وهو ما يبرر ضعف انتشار الحزب وقلة عدد منتميه.
ومن هنا فإننا نرى محدودية أيّ دعوة تقوم على ركنٍ معيّنٍ من أركان الإسلام، أو فرضٌ من فرائضه، مهما كان هذا الركن أو الفرض. فالسعة والشمولية هي سمة الدعوة إلى الله، وقصرُها على فرض من الفرائض، أيّاً كان هذا الفرض، هو خطأ في التصور والحركة جميعاً.
تناقض الإقرار بالديموقراطيّة ودخول البرلمانات:
لمّا كان العمل السياسيّ هو السبيل المُعتمد عند حزب التحرير للتغيير ابتداءً، فقد كان لابد أن يسمح الحزب لأعضائه بالعمل السياسيّ في ظلّ الدساتير الكفرية. ومبرر ذلك لديهم أنّ الدعوة إلى الخلافة هي دعوة استئنافية لا إنشائية، بمعنى أن المجتمع مسلمٌ بالأصالة، ومن ثمّ فإن الإشتراك في الأعمال والأشكال السياسية لا غضاضة فيه. وهذا التصور قد أوقع الحزب في تناقضٍ واضحٍ. فإنه وأن سلمنا بأن غالب سكان البقعة التي كانت تحت الخلافة حتى عام 1924، مسلمون، فإن ذلك لا يمنع من أنّ الحكم الذي هم واقعون تحته اليوم علمانيّ لا دينيّ. وكون السكان في هذه الرقعة مسلمون، لا يرفع حكم الكفر عن الأنظمة، ولم يقل بهذا أحدٌ ممن يُعتدّ بقوله، خلافاً لعلماء السلاطين والملوك. حتى الإخوان المعروفون بإلإرجاء العتيد قالوا بالإشتراك في هذه الأنظمة من باب جلب المصلحة ودرء المفسدة، لا من باب مشرعيتها المطلقة. ولا ندرى كيف يبرّر التحريريون هذا التناقض في رؤياهم السياسية العقدية.
هذا غير العوار في استدلالهم بطلب النصرة، واستشهادهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هذا براء، إذ إنه صلى الله عليه وسلم طلب النصرة بعد طلب الإسلام والدعوة له كما حدث مع أهل بيعتي العقبة، إذ قال جابر رضى الله عنه "فأويناه وصدقناه"، وهو خطأ تكتيكي جرّهم اليه عدم تماسك مذهبهم الفكرى، الذي أدى إلى محدودية انتشارهم، وإلى إدراكهم استحالة إقامة خلافة عامة، أو حتى دولة قطرية إسلامية بهذا الفكرن فلجئوا إلى موضوع النصرة هذا.
مشاكل عقدية عند حزب التحرير:
العقل عند النبهانيّ:
يثبت النبهانيّ وجود الله بالعقل، والعقل عنده لا يدرك إلا محسوسات، يقرنها بمعرفة سابقة، ليست هي المبادئ الأولية التي يقصدها أهل السنة كما أشار بن تيمية، بل هي ناشئة عن تلقى "معلوماتٍ" من الخارج كذلك، فيرجع الأمر مرة أخرى إلى الحِسّ، ومن ثمّ كان مذهبه حِسيّ بحت، وهو ما أشرت إلى اضطرابه فيه في المقال السابق. ولهذا فإن إثباته وجود الله بهذا الطريق خُلفٌ في الدليل. والرجل يجعل مسائل الإيمان الكبرى مبنية على العقل لا الوحي "وأما القيادة الفكرية الإسلامية فإنها مبنية على العقل، إذ تفرض على المسلم أن يؤمن بالله وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن عن طريق العقل" نظام الإسلام 43، وهو مخالف لمذهب أهل السنة في ذلك، الذين يرون الفطرة مع العقل مع الرسالات، كلها تعمل لإثبات التوحيد، وأن ليس على العاميّ النظر العقليّ البته لتصحيح إيمانه. والأمر هنا أنه إن كان الإيمان بالله مبنيّ على العقل وحده، أفيكون المرء مكلفاً به دون إرسال الرسل؟ وهو لازم قولهم، وإن قالوا إنه قد ثبتت ضرورة إرسال الرسل في القرآن بشكلٍ قطعيّ، فهي إذن ثابتة في العقيدة، إذ يجب وقوع التكليف به إذن، بغض النظر عن الثواب والعقاب، فإن قالوا: لا يلزم، وقعوا في التناقض (كذلك يمكن مراجعة مناقشته لمفهوم العقل في كتابه الشخصية الإسلامية ج 1 ص12 وبعدها ويحمل تفسيره تناقضات عديدة عن المبادئ الأولية وعن مفهوم الحسّ ودوره في بناء الفكر وارتباطه بمذهب الحِسّيّين من أتباع ديموقراطيس اليوناني، الذي هو سلف اتباع مذهب اللذة).
النبهانيّ وحديث الآحاد: وهي الطامة الكبرى والبدعة العظمى في منهج النبهانيّ، التي جاءت نتيجة ما وصل اليه من وضعٍ للعقل في التعامل مع النصوص، والتزام تلك التقسيمات المحدثة من قطعيّ وظني وغيرها، ثم ولوع أتباعه بها واعتقادهم أنه أتى بما لم يأت به الأوائل. فقد وافق النبهانيّ قول المتكلمين، الذين عارضهم من قبل في علم الكلام، عن أدلة مسائل الإيمان، في مسألة القطعيّ والظنيّ، ودرجتهما وموقع حديث الآحاد فيهما. فهو رغم دفاعه عن السنة بشكل عام، فرّق بين حديث الآحاد والمتواتر، فجعل الأول ظنياً وجعل الآخر قطعياً. وحرى بالذكر أنّ مسألة القطعية والظنية، ومسألة الآحاد والتواتر، هي مسائل نشأت بعد القرون الثلاثة الفضلى، وهي من الآثار الباطلة لعلم الكلام والمنطقيات، وتحكيم العقل الذي زعموا أنهم لا يحكمونه في الشريعة، فإن كلّ هذه التقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان. واستخدامهم لفظ "الظنّ" الوارد في آيات القرآن وصَبّه على أنه "الظن" الذي صاغوه مقابلاً لليقين منطقياً، لا اعتداد به ولا دليل عليه، بل هو من باب وضع المصطلح ثم الإستدلال عليه لاحقاً. فإن "الظن" في القرآن له معانٍ عديدة، منها اليقين "وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا۟ عَنْهَا مَصْرِفًۭا" الكهف 53، كما وردت بمعنى الشك "إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّۭا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ" الجاثية 32. فمن التحكم والإعتساف أن نحمّلها معنى وسطٌ في الحقيقة بين الشكّ واليقين، وهو معنى "الإحتمال". وهو ما نزعت اليه المعتزلة ومن تبعهم في هذا من المتكلمين ثم من التحريريين في هذا العصر.
وقد وضع أهل التقسيم بين الآحاد والمتواتر للتفرقة بين ما هو منقولٌ بعدد كبير وما هو منقول بعدد أقل، لا كمقياس يؤخذ به الحديث أو يُترك، بل هي بدعة إعتزالية كلامية بغيضة. والأصل أن الحديث إن ثبتت صحته سنداً، ورواه الثقات العدول الأثبات الحفاظ مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاد العلم، وأُخذ به، عقيدة وعملاً، كما أجمعت عليه طبقات أهل السنة والجماعة بلا خلاف، إلا المعتزلة ومتكلمي الأشاعرة. والتفريق بين العقيدة والعمل بدعة ضلالة لا دليل عليها. وهذا التبدع هو ما أخذ به النبهانيّ واتباعه كما صرّح في كتابه "الشخصية الإسلامية".
وقد قَبِل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلت صحابته، أخبار الآحاد، وكلف صلى الله عليه وسلم آحاداً بحمل رسالة الإسلام إلى غير المسلمين، كعمرو بن أمية الضمري ودحية بن خليفة الكلبيّ وعبد الله بن حذافة السهميّ وحاطب بن أبي بلتعة وشجاع بن وهب السديّ وسليك بن عمرو وعمرو بن العاص والعلاء بن الحضرمي وأبي موسى الأشعريّ وكثيرٌ غيرهم. وقد حاول النبهانيّ الخروج من المأزق الذي أوقع نفسه فيه بطريقين:
أولهما: قال أنّه فرقٌ بين البلاغ وبين قبول العقيدة، اي إنه ممكن في التبليغ في العقيدة، ولكنه ليس مُلزماً لمتلقيها!! وهو قول أقرب للخرق منه للعلم، فبهذا المقتضى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل رسله الآحاد هؤلاء لإبلاغ الناس العقيدة، لكن لم تقم بهم حجة عليهم ولا ألزمهم بقبول الإسلام بهذا البلاغ! ونترك للقارئ الحكم على هذا التعليل..
ثانيهما: فرّق النبهانيّ بين بين الإعتقاد الجازم وبين التصديق، فقال إنه يكون تصديقاً ظنياً ولا يسمى إعتقاداً! وهي بدعة أخرى التزم بها نتيجة التزامه نصرة مذهبه المنحرف ابتداءً. لذلك يموه عليك بعض منتسبى الحزب حين تسألهم عن الصراط والميزان والشفاعة والحوض، هل يؤمنون بها. فيقول هؤلاء نعم نؤمن بها، وهم يقصدون أنهم يصدقون ولا يعتقدون! وهذا تدليس باردٌ في القول لا يصح من مسلمٍ ابداً. وقد شابه قول النبهانيّ هذا ما عُرفَ عن أهل الكتاب الذين عرفوا النبيّ صلى الله عليه وسلم وصدقوه، لكن لم يعتقدوا في رسالته، جاء في ج3 من زاد المعاد " فلما وجَّهوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن نجران، جلس أبو حارثة على بغلة له مُوجِّهاً إلى رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإلى جنبه أخٌ له يقال له: كُرز بن علقمة يسايره، إذ عثرت بغلةُ أبى حارثة. فقال له كُرز: تعس الأبعدُ يريدُ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال له أبو حارثة: بل أنت تَعِسْتَ. فقال: ولِمَ يا أخى؟ فقال: واللهِ إنه النبىُّ الأُمىُّ الذى كنا ننتظرُه. فقال له كُرز: فما يمنعُك من اتِّباعه وأنت تعلمُ هذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القومُ: شرَّفونا، وموَّلونا، وأكرمونا، وقد أبَوْا إلا خِلافَه، ولو فعلتُ نزعوا منا كُلَّ ما ترى، فأضمر عليها مِنه أخوه كُرز ابن علقمة حتى أسلم بعد ذلك". فهذا هو ما استدل به أهل السنة على الفرق بين التصديق، بمعنى نسبة صدق الخَبر إلى المُخبر، وبين الإعتقاد، أي اليقين القلبيّ الذي يستدعى الإقرار والإتباع، وليس بينهما ثالثٌ إلا ما جاء به النبهانيّ في هذا الصدد، من قبيل عجائب طفرة النظام وكسب الأشعريّ وأحوال أبي هاشم[2]!
فالبدعة هنا هي في ذلك التفريق بين الآحاد والتواتر، وتخصيص أحدهما بالعقيدة، والآخر بالعمل دون العقيدة، ولو أنصف هؤلاء لرؤوا أنّ كلّ دليلٍ ساقوه على حجية السنة لا يفرق فيها بين هذا وذاك، إلا بالتمحك، واتباع الإبتداع. ولهذا قال أهل السنة بأن الأحاديث، آحادها ومتواترها، إن صحت دلت على العلم اليقيني بلا شك. ويجد القارئ ملفاً كاملاً في هذا الشأن إن أراد فيما كتب بن تيمية وبن القيم حول هذا الأمر، ودونك مجموع فتاوى بن تيمية والصواعق المرسلة لابن القيم وغيرهما. والحديث على خطل هذا المذهب لا يستغرقه مقال، بل يمكن أن تخرج فيه مجلدات، وإن لم يكن لها لزوم هنا إذ تكفل بها أساطين العلم من أهل السنة، فهدموا هذا البنيان البِدعيّ الواهى.
النبهانيّ ومذهبه في الصفات: يتبنى النبهاني، وبالتالي التحريريون، مذهب "المفوضة" في الصفات، وهو يعنى الإمساك عن إثبات الصفات أو نفيها، وتفويض أمرها إلى الله كنا قالوا. وهذا المذهب مخالفٌ لمذهب أهل السنة والجماعة الذي هو طإثبات بلا تمثيل وتتزيه بلا تعطيل"، فنذهب السلف أنهم يثبتون الصفة بلا كيف، كما أوضح مالك رضى الله عنه حين سئل عن الإستواء، قال: الإستواء معلوم، والكيف مجهول. فأثبت أن صفة الإستواء معلومة ولم يفوض معناها، ولكن كيفيتها هي المجهولة بالنسبة لله سبحانه. وقد أخطأ هؤلاء المفوّضة في فهمهم بعض ما ورد عن السلف بشأن الصفات حيث قالوا "أمرّوها كما جاءت"، فاعتقدوا أن إمرارها يعنى تفويض معناها ابتداءً، والحقّ أن إمرارها الذي قصدوه يعنى تفويض كيفيتها لا ظاهرها، لأن الله سبحانه تكلم بالصّفة، فوجب أن تكون مفهومة بقدرٍ ما للبشر، وهو قدر إثباتها، دون كيفيتها. وقد اتخذ هؤلاء من آية الأعراف "هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ مِنْهُ ءَايَـٰتٌۭ مُّحْكَمَـٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَـٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَـٰبِهَـٰتٌۭ" الأعراف 7، أنها من المتشابه. فانظر يا رعاك الله، أهم مسائل العقيدة التي عرّف بها الله نفسه، والتي ذُكرت في طيّات القرآن مئات المرات، هي من "المتشابهات"، يعنى ثلث القرآن أو ربعه متشابه، وتعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على اشتباه وجهلٍ بصفات الله! هذا ما يعتقده هؤلاء! فرسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر رسل الله عليهم السلام جاهلون بصفات الله (حاشاهم)، ولا يعلمون عنها شيئاً، بل يقرؤونها كأنهم يقرؤون حروفاً في لغة أعجمية غريبة عنهم! وقد ورد الردّ على المفوّضة[3] كذلك في العديد من كتب أهل السنة. وأنصح بمراجعة ما كتب بن القيم في هدم المبادئ الثلاثة التي أقام عليها دعاة التشابه في صفات الله مذهبهم، وهي "أنّ القرآن متضمن للمتشابه، وأن المتشابه هو صفات الله، وأن التشابه لا يمكن حصول العلم واليقين بمعناه" الصواعق المرسلة 185.
وقد قرر العلماء أن مذهب التفويض مآله إلى نفي الصفات، إذ كلاهما يقتضى نفي الظاهر، وهو ما يجعله أقرب للمعتزلة، نفاة الصفات، وإن أنكر ذلك مريدوه.
النبهانيّ وعقيدة الإرجاء في الإيمان: يقرر النبهانيّ أن الإيمان "هو التصديق الجازم"، وهو بذلك يتبنى رأي المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وهو مخالفٌ لإجماع أهل السنة من أنّ الإيمان قولٌ عمل، إلا ما كان من مذهب أبي حنيفة الذى أسماه أهل السنة "مرجئة السنة"، والذي اعتذر عنه كبار الأحناف وحاولوا تأويله، كما هو مبثوث في كتب أهل السنة كأصول الإعتقاد للالكائي، والعقيدة الواسطية، وكتب شرح السنة وما ورد عن السلف ومجموع فتاوى بن تيمية وكافة مؤلفات بن القيم، وسائر كتب العقائد، بما لا يدع مجالاً للحيدة عنه في مذهبهم، بل حكى بن تيمية الإجماع على ذلك، وقد تَحدّثت عن ذلك بالتفصيل في كتاب "فتح المنان في بيان حقيقة الإيمان" المطبوع طبعاتٍ عديدة في مصر منذ 1979، وبعدها.
وقد وقع الحزب ومؤسّسه في أخطاء عديدة أخرى، خالفَ فيها أهل السنة، منها رأيهم في القضاء والقدر وأفعال العباد، ومنها نفيهم للكرامات ولدور الدعاء في ردّ القضاء، ولتجويزهم وقوع الأنبياء في الصغائر، ومنهم تعريفهم للبدع وإجازتهم لهيئات وكيفيات في العبادات غير واردة في الشرع، وغير ذلك من مخالفات، كلها ترجع - في رأينا - إلى سبب مشترك، وهو تعظيم دور العقل، والالتزام بما يلزمهم من ذلك، ثم محاولة تبرير ما يصلون اليه من النصوص ولو باعتسافها.
وبعد ..
يجب أن أذكّر هنا أنّ النصوص التي نقلناها هي مما كتب النبهانيّ، لا من غيره، فإن مشكلة الأتباع هي التركيز على نصوصٍ تنصر ما رَسَخ في أذهانهم، ثم تأويل غيرها أو غضّ الطرف عنها، والأصل أن تتعاضد النصوص لا أن تتعارض، لتقرّ معنى واحداً. ولا يقال أن الأصل أن نجمع بينها كما نفعل في نصوص القرآن والسنة، إذ هذا لا يكون إلا إن فرضنا عدم الخطأ أو استحالة الاضطراب في حق الكاتب. فهذا النهج لا يصح إلا في أضيق نطاقٍ في حق البشر بعامة.
نحن لا نُنكر، ولا يجب أن ننكر ما لحزب التحرير من إيجابياتٍ منهجية، يمكن أن تكون عاملاً مساعداً في تحقيق هدف من الأهداف التي يسعى اليها المسلمون، وهو رفع الوعي السياسيّ الإسلاميّ لدى الأمة، لكن الناظر المُدَقق لا يرى لهذا المَنهج من فرصة في تحقيق أكثر من هذا القدر، لما يعتور المَنهج من سلبياتٍ أشرنا لبعضها فيما سبق.
ثم أعود فأقرّر أنّ هذا اللون من الكتابة، يُسبب لي ضيقاً وحَرَجاً، فإني أراه للهَدم أقرب منه للبناء. ولولا أنّ النقد له جانبٌ إيجابيّ يُعين على بيان الحقّ والبِناء على أرضيّة أصلب وأقوم ما تعرّضت له ابتداءً.
أعاننا الله على بيان الحق، واتباعه، آمين
[1] منها ما أنصف مثل كتاب الدكتور موسى السلميّ "حزب التحرير وآراؤه الإعتقادية"، ومنها ما توسط في النقد مثل الشيخ عبد الرحمن دمشقية، ثم منها ما شطّ وانحرف مثل محمد جمال باروت.
[2] هي مقولة معروفة في علم الكلام. وأبي هاشم الجبائي، وابراهيم النظّام من أكابر المعتزلة، والأشعرى هو أبو الحسن صاحب مذهب الأشعرية. والثلاثة لهم محدثاتٌ في مذاهبهم غير معقولة بالمرة. فالأشعريّ يقول بالكسب، وهو أنّ فعل الإنسان ليس من فعله بل هو من خلق الله، والإنسان يكسبه، فليس له فيه إلا الكسب، ليتوسط بين الجبرية الذين يقولون أن فعل الإنسان خارج عن إرادته، والمعتزلة الذين يقولون أن فعل الإنسان بإرادته وليس لله عمل فيه، ولم يفهم أحد ما يقصد بالكسب. أما طفرة النظام فهي قوله أن الأجسام قد تمر بمكان في انتقالها من نقطة أ إلى تاء دون المرور بنقطة باء بينهما وأخذ بها ليفسر وجود المخلوقات دفعة واحدة على الأرض دون تقدم بعضها على بعض. وأحوال أبي هاشم تعنى حالات الكينونة التي استبدل بها صفات الله، فإن المعتزلة انكروا الصفات، وخرج أبو هاشم بنظرة الأحوال التي هي حالات الله من حيث كونه عالماً وقادرا ومتكلما، فهي ليست صفات ولكنها كينونات
[3] وقد مرضت بوهم التفويض هذا شخصيا لفترة من عمرى في منتصف السبعينيات، ثم رحمنى الله بفضله سريعا، فشفيت منها قبل نهاية السبعينيات وإبّان تدويني كتاب فتح المنان في بيان حقيقة الإيمان، مع البحث المتعمق في مسائل الإيمان، فحمدا لله على هداه.