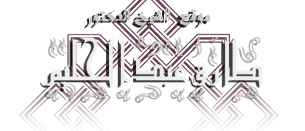الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
نشرت مجلة الوسط الإلكترونية رداً كتبه الدكتور صلاح الصاوى، على تساؤلٍ يختص بالعمل السياسي وتكوين الأحزاب، وما إلى ذلك من مسائل تتعلق بما يدور على الساحة السياسية في مصر، وما يخوض فيه الخائضون من ناحيته الشرعية (الوصلة بآخر المقال).
ولمّا كانت الإجابة تتعلق بأمرٍ جلل، ولما كانت النتائج التي وصل اليها الكاتب من الخطورة بمكانٍ، فقد رأينا أن ننقل هنا مقاله كاملاً، ثم نعلّق عليه بما هو أقرب إلى الفهم السنيّ وأطوع لأحكام الشرع من ناحية ومعطيات الواقع من ناحية أخرى، دون إفراطٍ أو تفريط.
وقبل أن نبدأ في سرد ما نراه في هذه الأمر، نود أنْ نوجه النظر إلى أمرين هامين، يجب أن يعتبرهما الباحث المحلل، حين يتناول عملاً من أعمال الفكر أو السياسة، وهما، توجه الكاتب وتاريخه.
والدكتور الصاوى، باختصار، من المفكرين الإسلاميين من أبناء الجيل القديم الذي بدأ خطاه في السبعينيات، فأنتج وحاضر وصنّف ما شاء الله له أن ينتج. وكان في هذا كله ممن ينزع إلى ما يسميه البعض التوسط في الرأى والبعد عن الغلو، وهو ما يسميه البعض الآخر جنوح إلى التفريط، وانحراف عن الوسط الأعدل. وهو أمر يجب أن يستصحبه الناظر في كتاباته بشكلٍ عامٍ.
والآخر هو تاريخ الدكتور الصاوى، ونقصد تاريخه في الفتوى. فقد كان د الصاوى دائماً ممن ينصر العمل السياسيّ والاشتراك فيه، ولو تحت مظلة الكفر، إذ نصر في مقالة تحت عنوان "رؤية فقهيـة حول المشاركة السياسية للمسلمين في أمريكا" (انظر العدد الخامس من مجلة المنار الجديد)! وهو ما ردَدت عليه حينها بمقال في مجلة "المنار الجديد" العدد الثالث عشر عام 2001 ، تحت عنوان "حكم المشاركة في العمل السياسيّ في الغرب". وللقارئ أن يتخيل القول الذي يخرج به من أباح المُشاركة في العمل السياسيّ في الغرب النصرانيّ، بشأن العمل السياسيّ في الشرق "المسلم".
وقد وقع التناقض في مقالات الدكتور الصاوى، كما وقع في تصرّفات السَلفيين المنزليين، بين مفهومه في التوحيد، وبين ما يدعو اليه عملياً من مواقف لا تتسق مع الأحكام المترتبة على تحقيق هذا التوحيد على الأرض.
أمر آخر نود أن نلفت اليه نظر القارئ، هو أن الأسلوب الرشيق، المليئ بالألفاظ الشرعية الكبيرة لا يعكس بالضرورة صحة قولٍ أو صواب توجه. والدكتور الصاوى صاحب قلم رشيق، ونَفَسٍ أدبيّ منذ الصغر، فلينتبه القارئ لهذا حتى لا تختلط عليه الأمور.
ولننتقل الآن إلى مقاله الأخير، حيث وضعنا قوله باللون الأسود، وردّنا عليه باللون الأزرق. ونسأل الله الهداية فيما نقول.
يقول الكاتب: "ولقد استقرت قرارات المجامع الفقهية التي ناقشت قضية المشاركة السياسية على أن العمل السياسي لنصرة الدين من خلال الأحزاب السياسية والمجالس البلدية أو النيابية أسلوب من أساليب الاحتساب واستصلاح الأحوال، بغية تحقيق بعض المصالح، ودفع بعض المفاسد، ورفع بعض المظالم، فهو ليس خيرًا محضًا كما يتوهمه المتحمسون، كما أنه ليس شرًا محضًا كما يظنه المعارضون، ولكنه مما تختلط فيه المصالح والمفاسد، وتزدحم فيه المنافع والمضار، فهو يدور في فلك السياسة الشرعية، ويتقرر حكمه في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، فحيثما ظَهرت المصلحة، ولم تعارض بمفسدة راجحة، فلا بأس باشتغال بعض الإسلاميين به، شريطة أن لا تستنفذ فيه الطاقات، وأن لا يحمل على الاستطالة على الآخرين، وأن لا يصرف عن الاشتغال بالأعمال الدعوية أو التعليمية أو التربوية، بل قد يكون الاشتغال به واجبًا في بعض الأحيان إذا تعين وسيلة لتحصيل بعض المصالح الراجحة أو تكميلها، وتعطيل بعض المفاسد أو تقليلها، وقد يكون حرامًا إذا عظمت مفسدته، وربا ضره على نفعه"
ونقول أمّا عن استقرار قرارات المجامع الفقهية على رأيٍ، فلا أدرى والله ما قيمة هذا الرأي في ميزان الحقّ؟ وأية مجامع هذه التي يتحدث عنها الكاتب؟ فإن الحق لا يتبع مجامعاً، وإن هناك من هم أرسخ في العلم وأدرى بقواعده من هؤلاء الذين تضمهم مجامع فقهية، تخضع لنظمٍ سياسية تملى عليها، في بعض أقوالها، ما يتناسب ومصلحة هذه النظم بلاشك. وهو باب لا نريد أن نفتحه حتى لا يشع العطن القابع خلفه فتُزكم أنوف وتُغْثى نفوس.
أما عن إختلاط المصالح والمفاسد في مسألة العمل السياسيّ، فهى مبنية على الخطأ الأصيل الذي يقع فيه الكاتب ومن حذا حذوه في هذه المسألة إذ مَحّضَها مسألة تتعلق بالمصلحة المرسلة بالكلية، ولم يراع فيها البعد العقديّ الذي هو قدر مشتركٌ في كافة التصرفات الإنسانية الإسلامية، وهو مطلق الطاعة لله، ليصحّ العمل أو يصح ويقبل على حسب موقعه من شروط التكليف. وقد عالجت هذه النقطة باستفاضة في كتاب "المصلحة في الشريعة الإسلامية"، والذي سيصدر إن شاء الله تعالى في الأيام القليلة القادمة، ويمكن الحصول عليه من مؤسسة "براءة"، فلا داعىّ للتكرار هنا إذ الأمر يحتاج إلى تفصيل وتأصيل لا محل له في مقالتنا هذه.
يقول: "أما القول بأن ولاية الرئيس مرسي ولاية غير شرعية لانها جاءت عن طريق انتخاب الدهماء وليس عن طريق اختيار أهل الحل والعقد، فهو قول عجيب، وأدنى ما يقال في الرد عليه على سبيل التنزل اتفاق أهل السنة على الإقرار بولاية المتغلب! وذلك لينتظم شمل المسلمين، ولتدرأ الفتنة التي تترتب على الصراع بين أشياع الوالي المتغلب وأشياع الوالي الأول، ولما يترتب على القول بعدم إمامته من بطلان أحكامه وعقوده وسائر تولياته، فهب أن ولاية مرسي لم تأت عن طريق بيعة صحيحة كما يزعم هؤلاء، فهو على الأقل وال متغلب، فقد ألقى إليه السواد الأعظم من الناس بمقاليد الحكم، ودانت له مؤسسات الدولة واعترفت له بمشروعية ولايته!"
قلت: خطأ فاحش بيّن في الرأي، فإن كلمة "ولاية" لا تنطبق أصلاً على حكم محمد مرسى، فهو وإن كان رئيساً للجمهورية بواقعِ ما حدث، وبموجب اختيار الدهماء، فهو ليس والياً شرعياً. والولاية الشرعية لها شرطان، أن تتم في ظل نظامٍ شرعيّ ، وأن تأتى عن إختيار سياسيّ شرعيّ، فإن فقدت أحدهما ترتب على فقده أثرٌ في توصيف من نُصِّبَ حاكما. فإن فقدان الشرط الأول يترتب عليه عدم الإقرار بالولاية إبتداءً، ويكون الخضوع للحاكم هنا هو خضوعٌ لنظامٍ لادينيّ من باب الإضطرار، حتى تسير أمور الناس ولا تتوقف الحياة، ويكون من باب خضوع المقيمين بالخارج لقوانين البلاد التي يقيمون بها. وإن فُقد الشرط الثاني كانت ولاية المتغلب التي هي ليست ولاية شرعية بمعنى قبولها في الشّرع، وإن حُكِم بصحة ما يترتب عليها، إذ فرق بين القبول والصحة كما يعلم من له باعٌ في الأصول. ومن هنا نرى أن الكاتب قد تجاوز وخلط بين هذه الأحوال، ما هو شرعيّ صحيح مقبول، وما هو شرعيّ مقبولٌ غير صحيح، وما هو غير شرعيّ إبتداءً. فالقول الفاصل في هذا الأمر أنّ محمد مرسى ليس والياً ولا متغلباً لإفتقاده لصورة التغلب أصلاً، بل هو رئيس جمهورية نافذ القول بصفة الضرورة لتحقيق المصالح ودرأ المفاسد المترتبة على الهَرَج والفوضى.
ويتابع: "ولقد سئل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه، وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله، ولا تفر منه، وإذا ائتمنك على سِرّ من أسرار الدين لم تفشه". ومن ناحية أخرى فإن تراتيب البيعة وآلياتها ليست من قواطع الشريعة وثوابتها، وإنما هي من مسائل السياسة الشرعية التي تتغير فيها الفتوى بتغير الزمان والمكان والاحوال، ولا أعلم أحدا ممن ينقل عنه العلم أو ينسب إلى الديانة في مصر ممن يفضل ولاية الفلول على ولاية مرسي، اللهم إلا إذا كان مغلوبا على عقله!!"
قلت: وهذا الذي جاء به الكاتب أعلاه صحيح في بابه، لكن لا يصح في الباب الذي نحن فيه كما ذكرنا من قبل، فهو قد أقام عناصر جدله على خطئ، وبنى بنيانه المنطقيّ على جرف هار، إذ سوى بين الإمامة المترتبة على تسليم النظام بشرع الله، والرئاسة التي جاءت في ظلِّ نظام شركيّ، تتنازع فيه الشريعة الإلهية والشرائع الدنيوية مصادر الحكم ومرجعية القوانين. ونحن نسلّم معه أنّ رئاسة مرسى أفضل من رئاسة شفيق ألف مرة ومرة، ولهذا فرحنا بها يوم انهزم شفيق، من باب الفرحة بقدر الله الكونيّ لا الشرعيّ. ولا نخالف أنّ تراتيب الولاية تختلف بإختلاف أوضاع الأمم، لكنّ هذا كما قلنا ليس مما نحن فيه، بل ذكره هنا هو من باب التمويه على العاميّ ليظن أن الأمر محكوم بالشرع.
ثم يقول: "أما الطعن في ولايته باعتبار مجيئها من خلال الديموقراطية فينبغي التفريق بين الديمقراطية باعتبارها آليات وتراتيب إدارية، والديموقراطية باعتبارها منهجية ومرجعية. فالديموقراطية باعتبارها منهجية ومرجعية هي التي يرد عليها كل ما يقوله المتحفظون، بل هي أقرب إلى الوثنية السياسية إذا نظر إليها في فضاءاتها الغربية، وفي خلفياتها العلمانية. أما الديموقراطية كآليات وتراتيب إدارية فهذا من جنس مسائل السياسة الشرعية التي تصطفي منها الأمة ما يصلح لها، وتدخل عليها ما شاءت من التعديلات والتحسينات لتتوافق مع ثقافتها وخصوصياتها الحضارية، فليس في الديموقراطية شكل مقدس، وإنما يمكن أسلمة هذه الآليات، وإدخال ما يشاء العقلاء عليها من تعديلات تجعلها أطوع للفكرة الإسلامية وللمفهوم الإسلامي في باب السياسة والحكم."
قلت: وهذا القدر غير مسلمٌ به كذلك، فإنّ علماء الإدارة والمتخصصين فيها يرون أنّ الآليات والفعاليات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأيديولوجيات التي تقوم عليه الهيئات والمؤسسات، قولٌ واحد. فهذا الانفكاك الذي يدعيه الكاتب لا دليل عليه من واقعٍ ولا علم. والأيديولوجية الديموقراطية قد خرجت من تحت عَباءة الغرب الصليبيّ، وقد بنوا آلياتها لتناسب هذا الغرض، فهذا الحديث الذي يظهر للقارئ أنه علميّ مُتقعّد، ليس صحيحاً بإطلاق، إنما هو الى ديباجة النثر أقرب منه الى تقرير العلم. ولعل دليلنا على ذلك هو ذلك التعبير الغريب "أسلمة الآليات"! ووالله لا أدرى ما يعنى الكاتب بهذا! سامحه الله، ولم لا تكون آلياتنا نابعة من أيديولوجيتنا الإسلامية المبنية أساساّ على الشورى وصلاحيات الحاكم، ومفهوم ولاة الأمر ودور أهل الحلّ والعقد، وسائر هذا الباب من أبواب السياسة الشرعية، بدلاً من "أسلمة الآليات"، التي لا تعكس إلا تبعية فكرية وقصور عقليّ لا يجرأ على التجديد في حدود الشرع الحنيف.
ويقول الكاتب: "ذلك أن تسويغ العمل السياسي في الإطار السابق لا يعني الإقرار بالديموقراطية في إطارها الغربي؛ بما تعنيه من تأليه الإرادة البشرية ونقل مصدرية التشريع من الوحي المعصوم إلى الأهواء البشرية، كما لا يعني كذلك تسويغ الاستبداد والمناهج القمعية، فإن الشورى من عزائم الأحكام وقواعد الشريعة، وهي تقوم على التفريق بين مصدر النظام التشريعي ومصدر السلطة السياسية، فالنظام التشريعي مصدره الوحي المعصوم قرآنًا وسنة وما حمل عليهما بطريق الاجتهاد، والنظام السياسي مصدره الأمة، فللأمة في إطار مرجعية الشريعة الحق كل الحق في الهيمنة على ولاتها تولية ورقابة وعزلاً، فالاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه، ومن بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا بيعة له ولا للذي بايعه تغرة أن يقتلا كما قال عمر رضي الله عنه."
ونقول: وهاهنا محاولة أخرى غير ناجحة في التفريق بين الديموقراطية وأساليبها، لا عملاً بل فكراً. فقد خلط الكاتب خلطاً شديداً في بيان العلاقة بين النظام التشريعيّ وبين بقية أجهزة الدولة ونظمها. والمعلوم المقرر أنّ السلطة في الدول الحديثة تنقسم إلى ثلاث سلطات متساوية، ومستقلة عن بعضها، التشريعية والتنفيذية والقضائية. وتُكوّن هذه الثلاثة منظومة الحكم في الدولة. وحين يقرر الكاتب أنّ "للأمة في إطار مرجعية الشريعة الحق كل الحق في الهيمنة على ولاتها تولية ورقابة وعزلاً"، فلا ندرى هل يقصد أمراً نظرياً لا علاقة له بالواقع؟ إذ المرجعية التشريعية في مصر ليست للشريعة الإسلامية على الإطلاق. ثم، إن تقريره هذا ليس صحيحاً بإطلاقه، فالأمة إن قبلت الشريعة مرجعاً كان للشرع القول الفصل في حق عزل ولاتها وتوليتهم والرقابة عليهم. وإطلاق القول بأن هناك ما هو لله، وهو المرجعية الشرعية، ما هو للأمة وهو الرقابة فيه افتئات على الشرع، إذ إن لله وللشرع حقّ كذلك في الرقابة والتولية والعزل، في إطار تلك الشريعة. فتجريد الحق للأمة هكذا بإطلاقه باب من أبواب العلمنة المستترة، نعيذ الدكتور الصاوى منها.
ويقول بعدها: "أما الطعن في ولاية الدكتور مرسي باعتبارها قد حددت لمدة معينة فقد علم المشتغلون بالسياسة الشرعية أن الإمامة عقد من العقود، تصح بما تصح به العقود، وتبطل بما تبطل به العقود، وأن طرفا هذا العقد: الإمام والأمة. فعلى الإمام واجب حراسة الدين وسياسة الدنيا به، وعلى الأمة واجب الطاعة والنصرة.
وإذا كان ذلك كذلك فما الذي يمنع إذا رق الدين وصادر الأئمة حق الأمة في الهيمنة والرقابة، وتحولت كراسي الحكم من تحتهم إلى مطايا للاستغلال والاستبداد - أن يشترطوا على الأئمة من البداية أن يكون اختيارهم مؤقتًا لمدة معينة، ثم يعود الأمر بعد ذلك إلى أهله - إلى جماعة المسلمين - لتستأنف اختيارهم وتجدد ولايتهم، أو تعدل عنهم إلى غيرهم في ضوء ما تسفر عنه سيرتهم في الحكم خلال هذه المدة المؤقتة؟! وذلك إذا ترجح هذا الأسلوب سبيلا إلى كبح جماح السلطة، وتمكين الأمة من الهيمنة على حكامها تولية ورقابة وعزلا، ووقايتها من حركات الخروج المسلح التي جرت عليها في تاريخها ما جرت من الفتن والمفاسد؟! وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتوى بجواز ذلك، بل ذكر أنه قد يكون هذا التحديد أرفق بالأمة وأقوم بمصالحها!
وهذا هو ما يقتضيه النظر الشرعي في ضوء مقاصد الشريعة وقواعد السياسة الشرعية بعدما تجرعت الأمة الغصص من الملك العضوض والحكم الجبري !! بالإضافة إلى أن ولاية مرسي ولاية قطرية وليست هي الإمامة العظمى التي تنشئ عموم النظر على عموم الامة."
قلنا: أما أمر تحديد مدة للحاكم، فإن تجاوزنا نقطة أنّ مرسى ليس والياً كما بيّناً، لكنه رئيسٌ لجمهوريةٍ لا تحكم بشرع الله تعالى، وإن كان غالب أهل ديارها مسلمون، فإن هذا الأمر، أمر تحديد مدة الولاية، يخضع للإجتهاد الشرعيّ، ويتحمل أيّ من الأقوال المعتبرة، كما تفضل الدكتور بذكر أحدها. والرأي الآخر، أن مقام الولاية العامة هو مقام خلافة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما في ولاية أبي بكر وعمر، حتى انتقلا إلى تسميتها إمارة المؤمنين، ليس نقلاً لها عن المفهوم، بل لتسهيل اللفظ لا غير. وهو ما يجعلها غير قابلة للتنحية طالما أنّ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمٌ بالمهمة ومؤهل لها، كما كان الحال على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفاصيل ذلك في كتب السياسة الشرعية.
يقول: "أما قضية الأحزاب فقد اختلف الباحثون في قضية التعددية الحزبية إلى ثلاثة آراء: الحرمة المطلقة، والجواز المطلق، والجواز إذا كانت داخل الإطار الإسلامي.
أما مأخذ القائلين بالحرمة فيتمثل فيما تفضي إليه التعددية من تشرذم الأمة وتفرق كلمتها، وما تتضمنه من عقد الولاء والبراء على ما دون الكتاب والسنة، وما تتضمنه كذلك من الحرص على الولاية والتنافس في طلبها، وما تقتضيه المعركة الانتخابية من تزكية النفس والطعن في الآخرين، وما تعنيه من الخروج على الجماعة ومنازعة الأئمة، بالإضافة إلى انعدام السوابق التاريخية، وفشل التجارب المعاصرة، وخطأ القياس على تعدد الأحزاب العلمانية.
أما مأخذ القائلين بإطلاق الإباحة فهو الاستشهاد بالفرق الإسلامية القديمة، وباستيعاب الإطار الإسلامي للمجوس والوثنيين وسائر الملل، وقد نوقش بأن الفرق ظاهرة مرضية إن سلم بوجودها فلا يسلم بإتاحة السبل أمامها طواعية لتكون في موضع القيادة، أما أهل الملل الأخرى فإنهم كغيرهم من أهل دار الإسلام ليس لهم الخروج على ثوابت الدولة ومرجعيتها التشريعية، وحقهم في العمل السياسي محكوم بهذه الأصول الكلية التي تجسد هوية الدولة الإسلامية.
أما مأخذ القائلين بالجواز داخل الإطار الإسلامي فيتمثل في أن هذا الأمر من مسائل السياسة الشرعية التي تعتمد الموازنة بين المصالح والمفاسد، ولا يشترط لمشروعيتها أن تكون على مثال سابق، وقاعدة الذرائع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب دليل مشروعيتها، فالتعددية أمثل طريق إلى تحقيق الشورى والرقابة على السلطة وصيانة الحقوق والحريات العامة، كما أنها الطريق إلى الاستقرار السياسي ومنع حركات التمرد والخروج المسلح، بالإضافة إلى بشاعة البديل وهو الاستبداد بالسلطة وما ترتب على ذلك عبر التاريخ من الإغراء بالقهر والتسلط، فضلاً عن أن الأدلة التي ساقها المعارضون موضع نظر، وأن ما ذكروه من مفاسد التعددية، منها ما يمكن تجنبه بالكلية، ومنها ما يمكن تقليله بحيث يبدوا مرجوحًا إذا ما قورن بما في التعددية من المصالح الراجحة، والذي يظهر أن هذا القول هو أولى الأقوال بالصواب في هذه القضية."
فنقول: مرة أخرى يفقد الكاتب بوصلة الحديث، ويذهب إلى نتائج بناها على مقدماتٍ لم يُسلم له بها المُعارض، ولم يأت عليها بدليل إلا ما كان من أمر "ما استقرت عليه المجامع الفقهية" التي جاء به أولاً ليقرر بعدها ما شاء من أقوال. فالإشتراك في الأحزاب، أو إنشاؤها، مرتبط بقضية شرعيتها تحت حكم علمانيّ لا يعتبر أحكام الشريعة مرجعاً وحيداً لنظامه. وهو فصل الخطاب في هذا الأمر. والحديث على التعددية هنا هو تعميةٌ على الموضوع الأساسيّ وإقرارٌ بما لم يقرّه الشّرع ابتداءً.
ثم كلام الكاتب على التعددية الحزبية، حتى في إطار ما ذُكر، يخلو من الأهم في هذا الباب وهو أنه لا يَصح إبتداءً التحزّب على كفرٍ أو بدعة، فلا يجوز إنشاء حزب علماني ولا نصراني ولا رافضي، فإنّ هذا خروجٌ واضح على ثوابت الإسلام. ولا ندرى كيف يوفق الدكتور بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه" وبين أن يكون هناك رئيس حزب يعلن اللادينية ورفض الشريعة، بل يتنافس على الحكم، إلا إن كان يأخذ بما ورد في كتاب التربية الوطنية المصري "من بدل دينه فاحترموه"!
فالتحزب في الشرع، إن جاز، لا يصح ابتداءً إلا في إطار مصالح الإقتصاد والعمران وما اليها من أحوال المعايش، بناء على برامج محددة تتناول هذه النواحي، لا على أيديولوجية مناهضة للدين. وهذا القول الذي صحّحه الكاتب، بناءً على أنه أفضل من التمرد المسلح، ليس له دليل شرعي واحدٌ، بله سابقة في تاريخنا كله، وما أجازه أحدٌ من قبل، فهو بدعة من بدعة على بدعة.
http://el-wasat.com/portal/Artical-55678628.htmlمقال الدكتور صلاح الصاوى أعلاه
http://www.tariqabdelhaleem.com/new/admin/index.php?ref=articles&iddoor=5&act=view&id=122 مقال معالم في الفكر السياسي الإسلامي - رد على مقال الدكتور صلاح الصاوى في حلّ الدخول في الأحزاب الغربية
ولعل مجلة الوسط تقوم بنشر هذا المقال من باب الأمانة الأدبية