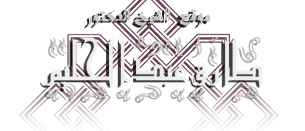الحمد لله والصّلاة والسّلام على رَسول الله صلى الله عليه وسلم
من المعروف، كما قرّر هنرى برجسون في كتابه "سيكلوجية الضحك"، أن أهم مُولدات الضَحك عند الإنسان هي المقابلة بين متناقضين، يصعب عادة وطبعاً، أن يتخيل العقل تلاقيهما. وقد تذكرت ذلك حين قرأت قصة "المليونية" التي قرّرتها بعض الطرق الصوفية، خاصة العزمية، نسبة لعلاء أبو العزايم، بالتعاون مع العلمانيين كالبرادعى والحمزاوى، حيث أثارت ضَحِكي، على ما في القلبُ من أحزانٍ موجِعة.
كيف يلتقى غَرضُ الصّوفي، الذي ينأي بنفسه عن الدنيا، ويعتبرها ظَاهرٌ لا حقيقة له، كما يدّعى، ويُقصِرُ النفس على القليل، ويزهدُ في المتاع، ويلفظ السياسة، ويضع الآخرة ورضاء الله فيها هدفاً أول وأوحد، كما يروج، مع غرض العلمانيّ، الذي يُنكر الإحتجاج بالآخرة، ويجعل الدنيا أكبر هَمّه ومَبلغ علمه، لا ينظر إلا اليها، ولا يعوّل إلا عليها، ويرسِم سياسته على أساس أن الدين إبتداءاً لا وجود له في حياة الناس؟ كيف يلتقى العِلمانيّ، صَاحب المَعقول، كما يدّعى، الذي لا يعترف إلا بما يرى، ولا يُقِرُ إلا بما يَثبُتُ في مجال الحِسّ ومعمل التّجارب، والذي يَجعل التّلازم السّببي أقوى من الإرادة الإلهية، مع الصوفيّ، صاحب اللامعقول، الذي تقوم عقيدته على الكرامات والولايات، وخوارق العادات، والإيمان بأصحاب الخطوات، وفصل السَبب عن المُسَبَب فَصلاً تاماُ وقاطِعاً، ويُعلن أن التوكّل يَستلزم الخُروج إلى الصّحراء دون زادٍ ولا مَاء؟
هذا التجمع، بين غَرضِ الصّوفيّ وغَرضِ العِلمانيّ، لا يفسّره إلا أمرٌ واحدٌ، هو إفلاسُهما جميعاً. فالعِلمانيّ، لو وجد له في الشارع من "المثقفين" كما يدّعى، ما يجعل له قوة ووجود، ما لجأ إلى صاحب الخرافة واللامعقولية، لنصرته، وتكثير عدده، والصوفيّ، لو كان آمن بتلك المزاعم التي يروّجها عن مذهبه بين أتباعه، من زُهد وتقشّف وبُعد عن الدنيا، ما لجأ إلى العِلمانيّ، يُعينه على أمر الدنيا التي تعيش حقيقة في قلبه، وإن غابت عن طَرف لسانه.
محمد البرادعي، وعمرو حمزاوى، والسيد البدوى (زعيم الوفديّة لا وليّ الصوفيّة!) وأمثالهم من مروّجي العلمانية اللادينية في مصر، يعلمون تمام العلم أن لا حقيقة لتواجدهم في الشّارع المصريّ بين الناس. وهم يعزون ذلك لِجهل الشعب، وإنعدام الثقافة، من حيث جعلوا لفظ "الثقافة" حِكراً على مذهبهم اللاديني المُتهالك. وهؤلاء يعتقدون أنهم وحدهم من اطلع على ما يرونه ثقافة، والتي هي نتاجُ العَقل الغربيّ أصلاً، مثل الفلسفة اليونانية من عهد هيراقليطس، إلى سقراط، وأرسطو وافلاطون. والمثقف، عندهم، هو من قرأ أعمال عمانويل كانت، ودرس رينيه ديكارت، ونظر في مثالية هيجل، وليبرالية جون لوك، ورعونات نيتشه، ورياضيات برتراند رسل وتأريخه، وفلسفة جماعة فيينا التي بلورت الفلسفة الوضعية المنطقية، والتي نَصَرها في مِصر زكي نجيب محمود، وتربويّات جون دووي، وشطحات باروخ سبينوزا، وتشكّكات ديفيد هيوم، ويوتوبيا توماس مور، أو ما دوّنه من تَفلسَف في الإسلام كابن سينا وابن رشد، وأبي حامد الغزاليّ، الذي هَدم أعمالهما في رائعته "تهافت الفلاسفة"، أو سلسلة مشكلات زكريا إبراهيم، وكتابات فؤاد زكريا في العصر الحديث، وغير ذلك كثيرٌ مما قرأه كلّ من إحترم قلمه أنْ يكتب في مسائل الإجتماع والعُمران، ويتناول الفِكر الإنسانيّ، دون إطلاعٍ على هذا الغُثاء المُتراكِم من نتاج العَقل البَشريّ، الذي إختلط فيه الحق بالباطل، والصالح بالفاسد. وهؤلاء لا يدركون أن الثّقافة، كما يرونها، ليست حِكراً عليهم، بل إننا ندّعى أن هؤلاء "المُثقفين"، السياسيين منهم والكتاب والإعلاميين، هم أنصافُ مثقفين، من حيث عدم قلة إلمامهم المُخزى بالثقافة العربية وعلوم الإسلام وثقافته. ولا أدلّ على ذلك من إعتراف أحد كبرائهم، وإن كانت قامته أشمَخ كثيراً من أقزام اليوم، وهو د.زكي نجيب محمود الذي إعترف بجهله الشديد بالثقافة الإسلامية، والتي حاول أن يَستسقى من بحارها في السنوات الأواخر من عمره، كما ذكر في كتابه "تجديد الفكر العربي"، وهو من هو في الفلسفة والأدب، ليس علاء الأسوانيّ أو سيد القمنيّ، وأشباههما وأضرابهما.
والصوفية الذين تَحالفوا مع الشّيطان، من أتباعِ أبو العزايم، قبّح الله وجهَه، هم منْ صَالَح النظام السابق وركب موجته ووالى وعادى عليه، فهم، حقيقة، فلول من فلول الحزب الوطني، يُساندهم فلول سياسية من بعض رجال "سرقة" الأعمال، والمنتفعين والمتطفلين على موائد الثورة، ممن يُسمون أنفسهم إئتلافات ثورية، وما هم إلا تورّمات ثورية، تريد أن تجد لها مكانا على الخريطة السياسية الجديدة.
هذه الجمعة التي يَدعون اليها، والتي أتَت الأخبار بفشلها قبل بدئها، لإعتراض عدد من الطُرق الصوفية الأخرى عليها، هي أضحوكة في زمانٍ قلّت فيه المُضحِكات، وزادَت في المُبكِيات، إلا مثل أمر هذه المليونية، المُضحكة المُبكِية.