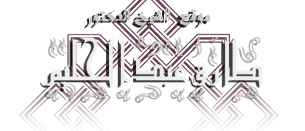(2)
- الجَماعة والطاعة في مفهوم أهل السنة:
يؤمن أهل السنة بقيمة العمل الجماعيّ في مجالاته، كما يقدرون الجهد الفرديّ، كلّ في إختصاصه، إذ كلاهما يكمل أحدهما الآخر. كما يأخذ أهل السنة بمفهوم السمع والطاعة، بشرط الوسطية القائدة في كلّ أمورهم. وهم لهذا يفرقون بين الطاعة والإنسياق، فالمسلم لا يُساق ولا يَنساق، بل يفهم ويُطيع. وهناك عدد من النقاط الهامة التي يحسن أن نقف عندها، توضيحاً وبياناً، وهى مما ينتمى غالباً إلى عِلم الفُروق، الذي يعزّ على الكثير تتبّعه بله تطبيقه.
- الفرق بين قول القاضي والمفتي والحاكم وأمير الجماعة
تختلف الفتوى في درجة إلزامها للمُستفتي حسب وَضعية الجهة المُصدرة لها، فإفتاء المفتى إرشاديّ غير ملزم تنفيذا، وحكم القاضي، ملزم قولاً لا تنفيذاً، وحكم الحاكم ملزمٌ قولاً وتنفيذاً، أما قرارت رئيس الجماعة أو أميرها أو مرشدها فهي قرارات ليست فيها صفةُ إلزامٍ من حيث صفة الأمير التى تصدر عنه، وصفة بيعته. وحين نتحدث عن الإلزام بالفتوى، يحب أن نفرق بين الإلزام الشرعي الذي ينتج عنه الإثم، وبين الإلتزام الإختياريّ الذي لا ينشأ عنه إثم أو معصية. والخلط بينهما هو السبب في التوجه للعَسكرية الإلزامية في فكر بعض الجَماعات. وفتوى المُفتى، في هذا الصَدد، أكثر إلزاماً للعَاميّ من قول أمير الجماعة، إذ هي تمثل قولاً شَرعياً لازم النفاذ (حسب درجة الحكم)، بينما قرار أمير الجماعة يمثل إجتهاداً في مناطٍ واقعيّ مبنيّ اساساُ على الخِبرة الشخصية والتقدير الخاص للأمور، لا على فقه الأحكام خاصة. ومثالٌ ذلك، ما نحن فيه من خلافٍ بين من يرى واقع المرحلة الحَالية هو واقعِ ما قبل الثورة بلا تغيير، ومن ثم، يرى ترك الفُرصة مُتاحة للعِلمانيين للإستيلاء على الحكم وتدوين الدستور، لحرمة الإشتراك في إنتخاب ديموقراطيّ، وبين من يرى أن مناط المرحلة الحالية مغايرٌ لما كان من قبل، وأن هناك نافذة من الشرعية يمكن أن يحاول فيها الإسلاميون كسب الدولة، وهزيمة اللادينية، وقطْعَ الطريق عليهم من أن يجعلوا الأمر على المسلمين أسوأ مرات في مستقبل الدعوة. وهذان النظران، قد بُنيـا على قراءةٍ للواقع، لا على إختلافٍ في الحكم، إذ كلاهما يؤمن بضَلال الديموقراطية، وضرورة الحكم بالشريعة، توحيداً لا إيجاباً.
- الفرق بين بيعة الجَماعة وبيعة الإمام
وهو فارق في غاية الأهمية من حيث أنّ الخلطَ فيه قد جَرّ إلى إلزام الأتباع بما لا يلزم، فبيعة الإمام بيعةٌ عامة وعقدٌ ملزمٌ بقبول الجانب التنفيذي في صفته كحاكمٍ. ولو تحدث الحاكم بإفتاء في أمر شرعيّ، لكان للمَحكوم أن يردّ عليه قوله، إن كان هناك أفقه منه، إلا إن حَمله على صفته كحاكم. أما بيعة الجَماعة فهي بيعة محدودة بحدود الأغراض التي تدخل في مهمة الجماعة أصلاً، وما يخدم هذه المهمة من أغراض، بشرط أن لا تتعارض هذه الأغراض مع مقاصد الشرع العامة، أو أحكامه الثابتة الخاصة. كذلك، يجب أن لا تتعارض هذه البيعة، نظراً لمَحدوديتها، مع القواعد الأصيلة التي سبق وأشرنا اليها في البند 1a, 1b.
- · الفرق بين الإفتاء للفرد، والإفتاء في أمور العامة
تقع الفتوى من المفتى على حسب واقع المستفتى وما يقدمه من ملابساتٍ للمفتى، وهي خَاصّة بالمُستفتي، لا يشاركه فيها أحد، ولا يصح تعديتها إلى غيره. أما الفتوى في أمور العَامة، فهي مَقامٌ بين الحكم الشرعيّ والفتوى. فهي فتوى من حيث إنها تنزيلٌ لواقعٍ إجتماعيّ يسرى على عامة الناس، على حكمٍ شرعيّ معين، كما إنها تشبه الحُكم الشَرعيّ من حيث إنها لا تخُصّ فرداً بعينه، بل هي، من هذا النظر، أقربُ للعُموم من الخُصوص. والتفريق بينهما هنا هامٌ في درجة الإلزام الشرعيّ، إذ الفتوى الخاصّة، وإن لم يكن لها صِفة الإلزام التنفيذيّ، تحمِل إلزاماً شَرعياً للمستفتي. والفتوى العامة، من هذا النظر، ليست لها قوة إلزامية شرعاً أو تنفيذاً.
- الفرق بين الخضوع للدليل والخُضوع للفتوى، والخضوع للقرار.
الأصل في دين الإسلام هو أن الناس عبيد لله سبحانه، وحده لا شريك له. ومقتضى هذه العبادة هي الطاعة لأوامره ونواهيه. وهذه الطاعة تتحقق بإتباع قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الدليل الشرعيّ الذي لا يصح لأحدٍ تجاوزه، اياً كان هذا الأحد، عاميّ أو مجتهد، بلا فرق. والفرق بين العاميّ والمجتهد في هذا الشأن هو طريق الوصول إلى الدليل الشرعيّ، وطريق فهمه على وجهه، وطريق تنزيله على الواقع. فالعاميّ ليس لديه أدوات الوصول إلى الدليل الشرعيّ إبتداءاً، كما يصعب عليه فهمه على وجهه الصحيح، لما يلزم من إعتياد الألفاظ الشرعية ودلالاتها. ولكن، هذا لا يمنع أن يكون العاميّ، على إختلاف في قدرات كلّ فردٍ، من أن يفهم المقصود من الدليل، كتابٍ أو سنة، إذ لا يكون إذن مؤهلاً للتكليف إبتداءاً. ومن ثم، يجب أن يدرك المتحدثون في هذا الشأن أن لا يتجاوزوا الحُدود في القول بعدم أهليّة المُقلد البتة، والنظر إلى المقلدين كلٌّ حسب مقدرته الحقيقية، إذ هذا مثالٌ لما ذكرنا من قبل في معرض الحديث عن الإفتاء في أمور العامة. ومن هنا، وجب على كلّ مقلِدٍ أن يطلب الدليل، ويحاول فهمه على قدر جهده، وهو أحد أوجه الإجتهاد الذى يجب عليه كما نبه العلماء، والوجه الثاني هو الإجتهاد في إختيار المفتى. والمقلد إذا نظر في الدليل، عليه السؤال عن وجه الدلالة، وكيفية إنطباق المناط على الحكم، ليكون قد استفرغ الوسع في معرفة الحق بالدليل. فإن عنّ له ما يثير القلق أو يجافي الفطرة، فلا يتحرج في السؤال، ولا يجب على المفتى أن يضيق به. فإن لم يقع الأمر على هذا الوزان، كان خضوعاً للفتوى دون دليل، وهو ما لا يصح إلا في طبقة خاصة من العوام.
أما عن القرار الصادر من قيادات التجمعات أو الجماعات، فهي أولى بالفهم والتمحيص من فتوى المفتى، من حيث إنها كلها مبنيةٌ على المناطات، إلا إن قرر الأمير أو القائد أو المرشد أنه يقوم مقام الإفتاء، حينئذ، يُطالب بإظهار حيثيات إجتهاده، ومبرراته.
ولعل الأمر الذي أشْكل على الكثيرين في هذا الصَدد هو الإشتباه بين السَمع والطّاعة في المَجال العسكريّ أو في الحروب بشكلٍ خاص، وبين قواعدهما في المنظومات الإجتماعية، ومنها الجماعات الإسلامية، التي هي، أولاً أخيراً، جماعات أمر بمعروفٍ ونهيّ عن منكرٍ. والفارقُ يتعلق بقاعدة النظر في المآلات، فالتساهل أو التلكؤ في تطبيق السمع والطاعة في المجال العسكريّ يؤدى إلى ضياعٌ الأنفس والأموال، أما في المنظومات الإجتماعية، فليست هذه الحالة قائمة، فتعود الأصول إلى ترتيب أهميتها، ويُطلب الدليل، وينظر اليه بموافقة الفطرة والعرف وما اليها، وما يمكن للطالب أن يستوعبه للفهم قبل التنفيذ.
فإن قيل، هذا يعنى تأخير الأعمال، والجدال حول كلّ قرار والسؤال، فهل يصلح عملٌ على هذا المنوال؟ أم يحب أن يكون الأمر كما نرى في المؤسّسات الكبرى، يصدر القرار وعلى التابع التنفيذ، قيل، هذا الإعتراض مردودٌ من وجهين، الأول أن المنظومات الأجتماعية لا تعمل بطريق المؤسسات التجارية، ولا منهجها ولا أعراضها، وإن اتخذت شكلاً تنظيمياً يوهم بذلك التشابه. والأمر الآخر، أن مسؤلية الإيضاح والبيان تقعُ على عاتق صاحب القرار، إن كان مدركاً لطبيعة هذه المنظومات، وإطار سيطرتها. فعلى صاحب القرار أن يشفع قراره إذن بما يوضحه أكمل ما يكون الإيضاح، بل وأراه واجباً لازماً عليه، إذ هو يتحدث في مقام الشريعة، كما أنه يعتبر مربٍ من جهة أخرى، وعليه أن يربي النشئ على إتباع الدليل. لكن الظاهر أنّ سوء فهمِ المَنظومات الإجتماعية، وقلة من تصدى للحديث عن طبيعتها وحدودها وأغراضها، جعل القادات تستسهل المنهج العسكريّ من ناحية، وتجده أهون عليها من طريقالإيضاح وإن خالف الحق. كما أن الأتباع استأنسوا بالسمع والطاعة المطلقة، لسهولة ذلك على عقولهم، ولأن الأمر أمرَ دينٍ وشريعة، فالتسليم أسلم.
- الفرق بين المَناطات الواضحات والمناطات المتشابهات
وهو أمر آخر، يجب أن يدركه الناظر في هذا الصدد، إذ إن الواقع، وإن كان واحداً في الخَارِج وعلى الحَقيقة، إلا إنه ليس واحداً بالنسبة لكلّ ناظرٍ فيه. وتختلف درجات التقييم حسب عوامل كثيرة جداً، منها الخلفية العلمية، وكم المعرفة، وظروف النشأة، والطبيعة الخاصة، والمؤثرات الخارجية، والمواقف السابقة، ودرجة الذكاء والوعي، والكمّ المتاح من المعلومات، ودرجة خفاء المناط، ودرجَة الهوى إن وُجِد (أعاذنا الله منه)، ثم قدرة يتيحها الله لمن أراد، تجعل المرء قادراً على قراءة الوقائع، ومن أحداثٍ وأفكارٍ وشَخصياتٍ أكثر وضوحاً من الغير، ولا حدود لهذه القدرة. ويذكرنا هذا بتمييز بن تيمية بين المقالات الظاهرة والخفية، وأثرها على الحكم في مجال عارض الجهل. كما أن الله سبحانه يهب أناساً ما يحبس عن غيرهم، تكليفاً وإبتلاءاً، كما ورد عن الإمام مالك والشاطبيّ وبن تيمية في مواضع مختلفة أن الله يرزق العبد قدرة على النظر في القرآن والأدلة. فالمناطات الواضحات لا إختلاف عليها بين من له فهم عامّ بأمور الحاضر، أما المناطات المتشابهات، فهي مما يَعسُر على العاميّ تقصيها، كما يعْسُر عليه الدليل. إلا أنه لمّا كان أمر المناطات أمر واقعٍ لا شرع مباشرٍ، إجترأ الكثير علي جنابه، وسهل على غير المؤهل تقحّم رحابه، مما يؤدى إلى الفوضى في الإفتاء.
- الفرق بين ما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز
والتقليد، وإن كان مذموماً على الجُملة، إلا إنه، كما بيّنا، وكما أفصح الإمام بن القيم في رائعته "إعلام الموقعين"، قد يكون مطلوباً بشُروطه، وهي مُحاولة فهم الدليل قدر الإمكان. إلا إنه لا يجوز التقليد بإطلاقٍ في عِدة أمور منها، وعلى رأسها ، التوحيد، وما عُلم من الدين بالضَرورة، وما يضاد المعروف فيما لم يأت فيه دليلٌ ثابتٌ، ولهذا يجب على العاميّ السؤال عن الدليل. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واصبة رضى الله عنه قال " جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ نَعَمْ فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْرِي وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ" رواه أحمد وصححه الألباني لغيره، وما يعضده من حديث أحمد عن أبي ثعلبة الخشني رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ" حسنه بن رجب والألباني، وحديث مسلم عن نواس بن سمعان رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ). وكلها تعضّد لنا "وما يضاد المعروف فيما لم يأت فيه دليلٌ ثابتٌ".
وأنقل هنا ما ذكره الإمام بن القيم في "إعلام الموقعين"، مما يلقى ضوئاً على هذا المعنى الفريد، قال تحت عنوان "إطمئنان قلب المستفتى قبل العمل بالفتوى": "لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه، وحاك في صدره من قبوله ، وتردد فيها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك) . فيجب عليه أن يستفتي نفسه أولا ، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه ، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من نار) . والمفتي والقاضي في هذا سواء، ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيحُ له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن ، سواء تردد أو حاك في صدره ، لعلمه بالحال في الباطن ، أو لشكه فيه ، أو لجهله به (يعنى جهل المستفتى بالحال أي بالمناط، وهو ما نحن فيه)، أو لعلمه جهل المفتي ، أو محاباته في فتواه ، أو عدم تقيده بالكتاب والسنة ، أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المُخالفة للسنة ، وغير ذلك من الأسباب المَانعة من الثقة بفتواه ، وسكنون النفس إليها" ج4ص254. وهذا النصّ يضع الأمور فى نصابها كما بيّنا والحَمد لله على المنة.