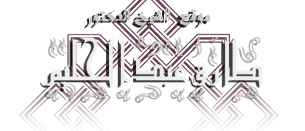الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أزعَجنى كثيراً ذلك الحوار الذي دار بين الشيخ الفاضل عبد المنعم الشّحات، وبين اثنين من اللادينيين المِصريين، المستشار أحمد ماهر، وعبد الرحيم على "الخبير" في شؤون الجماعات الإسلامية، على برنامج "أنا المصرى". ذلك أن الضيف العِلمانيّ أحمد ماهر، قد افترى على الله كذباً من ناحية، وتعمّد الخلط بين المفاهيم والمُصطلحات من ناحية أخرى.
ومن المُلاحظ أن كافة هؤلاء العِلمانيين، ممن يطلقون عليهم "مستشارون" أو "فقهاء دستوريون"، كأحمد ماهر هذا، أو عدو الله والشعب يحي الجمل، أو إبراهيم درويش، أو غيرهم، هم من الجيل الذي نشأ قبل إنقلاب يوليو 52. ذاك الجيل الذي تربي على خلفيةٍ سياسيةٍ رعاها الوفد القديم، بقيادة مصطفي النحاس، بعد هلاك سعد زغلول، وعايش المَدّ الثقافيّ التغريبيّ في أشد وأعتى مراحله، أيام كان طه حسين عميدا ثم وزيراً للتعليم، وما أدراك ما طه حسين وزيراً للتعليم! وذلك على يد حكومة وفدية، وبركة أخرى من بركات الوفد. فجُلّ هؤلاء إذن، قد تشربوا ثقافة لادينية في تعليمهم الرسميّ، وورَثوها فِكراً ممن اتخذوهم مُثلاً عليا. ولاجَرم أن يكون غالب خريجي الحقوق، من هذا الجيل، هم ممن ينتمى لهذا التيار اللادينيّ، ثم إذا هم يبثون سمومهم التي كرعوها عقوداً، علينا وعلى الشعب المسكين، متلفّعين بشيبٍ لم يُجْدِهِم إلا تقرّباً من أباطيل الوفد، وشعارات "الدين لله والوطن للجميع".
ثم إنّ بناء العِلمانية اللادينية في مصر يقوم على مجموعة من المُغالطات والتلفيقات، التي يُقصَد بها، في نهاية الأمر، تنحية الشريعة عن الوجود في حياة الناس فرادى وجماعات. فكما غالطوا في مفهوم ما يسمونها بالدولة المدنية، والتي لا يعلم إلا الله ما يقصدون بكلمة "المدنية" هنا؟ فقد غالطوا في أمر آخر أشدّ خطورة، بدهاءٍ وخُبثٍ، إنطلى مع الأسف على كافة من حاورهم، فجاراهم فيه، ثم راح يحاول أن يردّ على باطلهم، وهو جدلٌ ساقطٌ من الأصل، ونعنى به قولة "لا يجوز الخلط بين الدين والسياسة"، إذ هو ، إلى جانب خروج صاحبه من الدين، من النّاحية الشَرعية، مغالطة واقعية مُجرِمة مَقصودة. وإليك البيان.
السياسة، في مفهومها الشرعيّ والوضعيّ، تعنى أمران، أولهما رئيس، وهو تلك الخُطوات الإجرائية التي يرتضيها المجتمع، ويتخذها وليّ الأمر لتنفيذ ماتنص عليه قوانين الدولة، ومنهجها العام داخلياً وخارجياً. وحين ألفّ علماء المسلمين في موضوع السِياسة الشّرعية، كابن القيم والماوردى وغيرهما، فقد تناولوا معنى الإمامة وشروطها ومن يصلح لها، ثم نواب الإمام من الولاة، او الوزراء، وهذا هو الغالب الأعم من أبوابها، مما يجعلها أقرب إلى تقنين طرق الحكم وشؤون الولاية، من اي شئ آخر. أما السياسيون، فمن المعلوم إنهم ذلك النّفر الذي يُعنى بما عليه الحاكم من إلتزام بما عقد عليه مع من وكّله، وهو الشَعب، وأنه يجرى في تطبيق هذه الإجراءات دون تعسفٍ ولا إخلالٍ بمصالح الناس والرعية.
ثم الجانب الآخر، من مفهوم السياسة، هو ما ورد كذلك في كتابات علماء المسلمين، مما يتخذه الحاكم من إجراءات إستثنائية حين يقع ما ليس فيه حكم شرعيّ خاصٌّ، أو فتوى مسبقة، مما يجدّ من احداث. أما ما كانت فيه الفتوى، أو وُجد فيه الحكم الثابت، الذي يناط به للفتوى، فلا دخل للسياسة فيه، لا عُرفاً ولا شَرعاً. إذن، هذا الجانب من السياسة معنىّ بما هو من قبيل المصلحة المرسلة. وقد ألحقوا هذا الجانب الفقهىّ بالسياسة، إذ لم يكن هناك من يخالفُ فيما ثبت من شرع الله، كمن ابتلانا الله بهم في عصرنا هذا من اللادينيين العلمانيين.
والشريعة هي القانون الذي انزله الله سبحانه ليحكم به الناس فيما بينهم "وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ" المائدة 49. وهو مما لا يحتمل جدالاً أو إثباتاً.
والقانون، بمعناه الوَضعيّ، هو قرينٌ مُضادّ لأحكام الشريعة الإسلامية، تتوفّر فيه كافة أركان التشريع، من أحكام تكليف ووضعٍ. فالقانون، إذن، هو مجموعة أحكام تغطى جوانب الحياة كلها، إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً، من كلا جانبيّ السياسة، ما يختصَ منها بالحاكم، وما يختصّ منها بما يناط بالحاكم استصداره، بصفته والياً على الناس، لا بصفته مُشرّعاً، مما لم يثبت بشرعٍ محكمٍ، وإنما دَخل تحت قاعدة شَرعية عامّة، لا بدليل خاصّ.
أما علماء القانون الوضعيّ، من الغربيين، فلم يكن بهم حاجة إلى هذا التخصيص، بين السياسة الشرعية، خاصة بجانبها الخاص بأحكام المصلحة، إذ ليس للقانون الوضعيّ مرجعٌ أصلاً إلا فيما تواضع عليه الناس ورضوا به، دون أي مرجعيةٍ إلهية في هذا الصدد. فالسياسة في عرف هؤلاء هي تصرف الحاكم حسب القانون الوضعيّ بلا مرجعية إلا إهواء الناس، في كافة جوانب الحياة.
والدينُ، المقصود في الدين الإسلاميّ، هو تلك الثوابت العَقدية التي يؤمن بها المسلمون أفراداً، ثم تلك الأحكام الشرعية التي ذكرنا، والتي تنظم كافة جوانب الحياة إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً، عائلياً وشَخصياً ومالياً وتجارياً وجنائياً، بما فيها ما يقع تحت دليل المصلحة المرسلة.
فالدين إذن قانون – أي تشريع – وسياسة معاً. هذه واحدة. ومن هنا فلا يمكن أن يُعَارَضُ الكليّ بأحد أفراده.
إنما تكون المُعَارضة بين جزئيين، أو كليين. فإذا إعتبرنا الدين كليّ، والسياسة كليةٌ، كما في منهج الغرب، تعارضا، ومن هنا جاء تعبير "الفصل بين الدين والسياسة"، غربيّ في مصدره، غربيّ في مفهومه.
واللادينيين العلمانيين في بلادنا، لا يصرحون بأن الدين والسِياسة وجهان لعملة واحدة، أو أنهما متساويان. ومن هُنا وقعوا في التناقض المذكور أولاً، ثم عنّ الخلط، فإنما يخلطون بين القانون والتشريع، لا بين الدين والسياسة ثانياً.
هؤلاء لا يريدون أن نخلط دين الله بالقانون الذي يحكم الأرض. هكذا بكلّ بساطة. وإنما يجعلونَه خَلطاً بين الدين والسياسة خِداعاً ومكراً بالعامة، فيصورون الدين على أنه العقيدة، ثم السياسة على أنها أمور الحكم مما لا دخل للدين فيه. إضطرابٌ على تخليطٍ على تخبطٍ، ظلماتٌ بعضها فوق بعض.
إذن، يجب من الآن فصاعداً أن يتحدّد موضعَ الخلاف في تلك الحِوارات الدائرة، ويجب على المُسلمين من المُتحاورين أن يبيّنوا مَوضع الخِلاف أول ما يتحَدثوا. فالخلط ليس بين الدين والسياسة، بل هو بين الشَريعة والقانون. المُسلمون يقولون شريعةٌ لا قانون، واللادينيون يقولون قانونٌ ولا شريعة، واللادينيون يقولون لا خلط بين الدين والسياسة، والمسلمون يقولون لا خلط بين القانون والشريعة، فمن أحق منهما بالإتباع؟ "أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّىٓ إِلَّآ أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ" يونس 35.