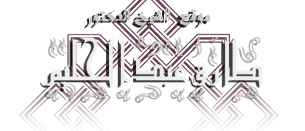الحمد لله والصلاة والسلام على رَسول الله صَلى الله عليه وسلم
لعل الوقت قد حان أن نعيد النظر في منهج التغيير، الذي يتبنّاه أهل السنة والجماعة، أفراداً وجماعات، للوصول إلى إقامة شرع الله في النفس وفي الأرض، والذي يتلاءم مع ثوابت عقيدتنا، ويتماشى مع المُتغيرات التي مَاجت بها ساحتنا في الشهور الماضية، والتي ولا شك أثارت قلقاً ومخاوفاً وحذراً، قدر ما أثارت ارتياحاً وأملاً وتفاؤلاً، فإن في ذلك جَمعٌ للشمل ودرأٌ للتشتّت والفُرقة، حتى يتّضِحُ برنامج العَمل وخطوات الطريق. وما أردت هنا أن أرسم خطاً أوخطة متكاملة الأبعاد، فإن ذلك يحتاجُ غلى أكثر من هذا الجهد، ولكن أردت أن أبين علامات، وخطوات، ليبدأ حواراً يشاركنا فيه أكابرنا نحو تحديد الخطة المتكاملة. وسنعود مرة أخرى بمزيد من التوسع إن شاء الله.
وسيكون سبيلنا إلى توضيح هذه العلامات، أن نحدد:
- علامات على طريق المنهج.
- علامات على طريق العقيدة.
- علامات على طريق العمل.
أولا: علامات على طريق المنهج
منهج النظر: حين نتحدثُ عن المَنهج، فإنما نعنى به تلك الطُرق والمَسالك العقلية التي تصدُر عن موارد الشرع وأصوله وكلياته، وتهتدى في طرقها بهديه لا تتجاوزه، والتي ينبنى عليها المَنحى العمليّ في تناول الواقع والوصول إلى الحق على مراد الشارع. وقد سبق أن أشرنا إلى مفردات هذا المنهج من قبل في كثير ممّا دوّنا، لكن تكفى هنا الإشارة إلى إنه وإن استند المنهج في كثير من مناحيه إلى علمىّ الأصول والفروق في وضعهما التقليديّ، فإنه أعمّ وأشمل من حيث إنه يتجاوز إلى إعتبار المقاصد الكلية للشرع، وإلى كلياتٍ عدة في مناهج عدد من العلوم الشرعية الأخرى كعلم الحديث.
ومنهج أهل السنة والجماعة، حسب ما عرّفناه آنفاً، ثابتٌ لا يتغير ولا يتبدل، وكيف يتبدلُ وهو مَبنيّ على ثوابتٍ كليةٍ مستنبطةٍ من رواسخِ الشريعة وقواعدها الثابتة على مر الزمان والمكان والحال.
ولو ذهبنا نستقصى مُفردات هذا المَنهج لخَرج المَقال عن غرضه، ولكن يكفي أن نشير إلى مثالاً من بعض أسسه وعلاماته، ومنها:
- أنّ القرآن والسّنة الصحيحة هما المَرجعان الوحيدان لكل ما يعرِض للإنسان في شؤون حياته، إما نصاً أو استنباطاً وإجتهاداً، لا يتجاوزهما إلى غيرهما.
- أن العقلَ تابعٌ للشرع لا متبوعٌ، وأن العَادات مُحكّماتٌ فيما لا يُعارض شرعاً، نَصاً أو إجتهاداً.
- أن إدراك مَقاصد الشرع ضَرورىّ لمواضع الإجتهاد، ولتوجيه النظر في المَسائل الجزئية، لكن لا تصح بمفردها كدليل للخروج عما ثبُت بالنَص في موضعه، أو عن مقتضى قاعدة كلية عامة إلا بقياسٍ خَفي أو استحسانٍ يعدل بها إلى أخرى. فلا يصحُ أن يتجاوز الناظر ما ثبُت جزئياً أو كلياً، في الشريعة، إلى الإستدلال بمَقاصدها بدعوى المَصلحة، كما يُحاوله العِلمانيون، للتفلت من التكاليف.
- أن الإجتهاد ضَرورىّ في الشرع، والتقليد المذموم محرّمٌ على من لديه القدرة على النظر إستقلالاً، والإتباع بالدليل واجبٌ على كلّ من لديه القدرة على فهم الدليل والتفرقة بين الأحكام الشرعية، وهو أمر يرجع إلى المناط الخاص بكلّ مكلف.
وعشراتٌ من العلامات التي لا يتسعُ المجال لإستيعابها هنا. وهذا المنهج كما ذكرنا لا يقبل تعديلاً ولا تغييراً.
ثانياً: علاماتٌ على طريق العقيدة:
وهي كلّ ما يقتضيه عقدُ الشهادتين من توحيد الألوهية والربوبية، وإخلاص التوحيد لله في كلّ أمرٍ وشأن، بالرجوع إلى شرعه، والتحاكم اليه، خلافاً للعلمانيين اللادينيين، وموالاة أولياء الله والبراء من أعدائه، صراحة وإعلاناً، خلافاً للسياسيين ومن تابعهم من الإخوان قصداً او تأويلاً، والتوجه إلى الله وحده بالنسك والشعائر، لا ندعو ميتاً ولا نذبح على النُصب، خلافاً للصوفية من أهل البدعة أو الكفر. وعلى هذا الطريق علاماتٍ مُحدّداتٍ، يجب أن ينتبه اليها السالك في درب التوحيد، منها:
- التمييز بين ما هو من أصل الدين ولبّ التوحيد، وما هو من فروعه، وهو أمر عزّ على الكثير من طلاب العلم لخفائه ودقته، وإن ظهر غير ذلك لبادى الرأي.
- التقيد بشروط الشارع في إطلاق الكفر على الأعمال خاصّة ما استُحدثَ منها في العُصُور المُتأخرة، إلا بعد أن يثبت إنها مسقطة لأصل الدين ولبّ التوحيد.
- التقيد بشروط الشارع في إطلاق الكفر على الأفراد تعييناً، إلا:
- بعد أن تظهر الحَاجة اليه، كمن هم يفسدون على الناس دينهم في الإعلام أو غيره.
- يثبت يقيناً ان موضوع خلافه هو من أصول الدين والتوحيد، وان مناط قوله مناطٌ مكفّرٌ
- أن تنتفي عنه شبهة التأويل، أما عن شبهة الجهل، فقد انتشر العلم بالتوحيد بما لا يَجعل الجَهل حُجة، ذلك فيما فيه الجهل حُجّة أصلاً، ويُرجع في تفصيل ذلك إلى كتابنا "الجواب المفيد" أو كتب الشيخ الفاضل عبد المجيد الشَاذليّ.
ثالثاً: علاماتٌ على طريق العمل والحركة:
وهو منهجٌ حركيّ يقوم على مبادئ المَنهج النظري الإستدلالي، ويراعي مُتغيرات الواقع بحسابات دقيقة، لاتجور على المنهج ولا تفتئت على العقيدة، لكنها لا تجمد على فتوى ولا تحترز من إجتهاد. فنحن نمَيّز بين الجُمود وبين الثبات على المَبدأ، بين التميَع وبين الإجتهاد في حينه، كما نُميّز بين العِزة وبين التهَور، بين الصَبر وبين الذلّة. وذلك بما نقرأ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته رضى الله عنهم، ويقوم هذا المنهج على عدد من المُعطيات وإلإعتبارات، التي ينبنى عليها عدد من الخطوات، نورد منها مثالاً حتى لا نخرج عن سياق ما أردناه هنا:
- الأمة المُسلمة، ككِيانٍ مَعنوىّ يتحاكمُ إلى شَرعِ الله ويلتزمُ شَرائِعه، لم تعد مَوجودة على الأرضِ منذ أن سَقطت الخلافة.
- المُسلمون في دِيارهم لا يزال أكثرهم على الإسلام، وإن غابت عنهم كثيرٌ من مُسلماته ومَبادئه، بسبب مكر الليل والنهار من النُظمِ الكفرية والعَدو الخَارجيّ المتربّص، واستبدلوها بمفاهيم تنتمى إلى الجاهلية المعاصرة، وهو ما يجعل مُهمة الدعوة واضحةٌ جليةٌ في إعادة البِناء العَقدى للأمّة.
- الحُكام الذين يُعرِضون عن شرع الله ويلزمون الناس قهراً وغَصْباً، او تلاعباً وتحيّلاً، على التحاكم إلى غير شرع الله من قوانين وضعية، وتشريع ما يُخالف حكم الله في مجالس نيابية تجعل سلطة التشريع للشعب وإن خالف حكم الله، هم كفارٌ كفراً أكبر ناقلاً عن المِلة، ويجب قتالهم للقادرِ على ذلك بشروطه.
- الولاءُ الحِزبيّ على غير أسَاس من الشرعية الإسلامية السّنية الصَحيحة، يتراوحُ بين الفِسق والكفر حسب درجة الولاء والمبادئ الحزبية الموالى عليها.
- القتال لإستعادة الشَرعية الإسْلامية هو ضرورة بشرطين، أولُهما أن تفشَل المحاولات السّلمية المبنية على أسس شرعية في هذا الصَدد، والتي لا تُعارض شَرعاً ولا تتعدى على عقيدة، حقناً لدِماء المُسلمين، ودرءاً للهَرج والتقاتل الذي يُضاد قصد الشارع في إقامة الشرع إبتداءاً. والثانيّ، أن يكون الإعداد لهذه المُواجهة مع الجاهلية متناسب مع قوتها وسيطرتها، بحيث لا يؤدى إلى خلاف المقصود من قطع شأفة المسلمين وفنَاء بَيضَتِهم.
- بناء الإنسان المُسلم يكون بتوجيهه لجِهادِ أعدائِه الثلاثة الذين ذكرَهم الإمام بن القيم رحمه الله في زاد المعاد ج3، النفس والشيطان والكفار، ولا يَصح أن يجورَ جِهاد أحَدِهم على الآخر، ولا أن يُهمِل أحدُهم لحسابِ الآخر.
- إعادة صِياغة الأمة وبناءها حسب المفهوم الصّافي للتوحيد أمرٌ مقطوعٌ بوجوبِه في كلّ آن، لا يتوقف على إجتهادٍ ولا تمنع منه ظروف. وهو فرضُ عينٍ على القادر بشروطه، لا يصح التخلف عنه.
- بناء الإنسان المُسلم يكون بإعادة معاني الرُجولة والعِزة والشّهامَة والصَبر والكَرم والكَرامَة وحفظِ العَهد والميعاد والإيثار والعِفة والسَمَاحة، وسَائر الأخلاق التي تحلّى بها العَرب وشذّبها الإسلام.
- السَعي الحثيث لإستعادة سيطرة الإسلام على الدولة بكافة ما يمكن من طرق وأساليب، منها زيادة الوَعى بمعاني التوحيد، مما يزيد من ثقل المُسلمين، وقوة حرصهم على تحكيم الشريعة، إلى أن يكون هناك طريقٌ للتغيير التام سواءاً بثورة مسلمة خالصة دون شوائب، أو بأي طريقٍ مَشروعٌ آخر يتيسُر حينها.
- أن التعامل مع الفرق المُتأوّلة البدعيّة كالإخوان، حيث يَستخدمون الديموقراطية كبديل عن الشورى، ويقبلون بحكم الشعب من حيث أن الغَالبية العظمى مُسلمة إبتداءاً، يصِحّ في مراحل ضَعف أهل السّنة والجَماعة، كما هو واقعنا اليوم، حيث لا يوجد ممثلين لأهل السّنة يمكن أن يعينوا على تحكيم الشريعة، إلا من أمثال الشيخ حازم ابو إسماعيل، الذي يجب دعمه لتوجهه الإسلامي القوى. وهذا التعاون يأتي من باب حلّ الصلاة وراء الإمام الفاسق والجهاد معه، كما ورد في الشريعة لمنع سيطرة الكفار من اللادينيين على حكم البلاد، مع بدعهم وخروجهم عم الشرع بالتأويل المانع من الكفر. ويبقى تصحيح المفاهيم وإعادة بناء الأمة حتم قائمٌ على أهل السنة، لإحلال رجالهم مَحل أهل البدعة والتزَلف من الإخوان.
- أن أولئك الذين يحرّمون المشاركة في الإنتخابات اليوم، ويمَكنون من أن تثبت سَيطرة اللادينيين على الحكم، بناءاً على أن مناط الأمس هو مَناط اليوم، قد وقعوا في خطإ كبيرٍ من حيث رؤية الواقع، وتقدير مُعطياته، ولولا أن الواقع قد اختلف كثيراً، إلى حين، ما كانت هذه الحَملة الشّعواء على الإسلام، وعلى المادة الثانية، وعلى كلّ ما فيه ريحة الدين أصلاً. ذلك أن هؤلاء عرفوا أن الأرض اليوم سَيملكَها من أحياها، إذ سقطت المِلكِية السَابقة، وإن زَعموا غير ذلك. ولا مُبرر إطلاقاً لترك فرصَة سَانحة، بتحكّماتٍ لها أوجه، لا يمكن الجزم بوجه منها على سبيل القطع واليقين.
- أن تكوين جبهة إسلامية لأهل السنة والجماعة (ليست حزبا رسمياً، بل جمعية او ما شابه)، هو أمر تفرِضُه مقتضيات الواقع الحاليّ، وأن تكون لهذه الجبهة أمانة، وفروع في كلّ محافظة، ومدينة. وذلك لأن حَالة التخبّط التي تعيشها حركة أهل السنة والجماعة تجعل من كلّ عملٍ عبثاً من غير طائل. والتنظيم والتوحد، والتفاعل مع الموافقين أمر لابد منه لمواجهة المخالفين. ومن هنا يجب أن يبدأ العمل الإيجابيّ لأهل السنة والجماعة، ولا نقنع بمجرد الرّفض وبيان أخطاء الآخرين، فخطؤنا الأكبر هو في الركود الذي قد يصِل إلى الرّكون، والمناخ يسمح الآن، إلى حين، أن نتحرك تحركاً إيجابياً، فلا نضّيّعَن هذه الفرصة كما سبق أن ضَيعناها في السَبعينيات.
وغيرَ ذلك كثيرٌ من العَلامات والخُطوات. وما أردتُ في هذه العُجالة إلا إلى بيان أن العمل الذي أمامنا جِدّ خطير وكبير. إن التغيير المنشود للواقع الموجود كما أنه لن يكون خالصاً بمجرد المشاركة في هزيمة اللادينيين، فإنه لن يتم بالقعود ومجرد رفض المشاركة السياسية، بل يجب التحرك الجادّ العمليّ الموحّد الشامل، الذي يجمع أهل السنة في أطراف البلاد، فقد تركوا الساحة للسلفيين من أتباع كلّ صاحب سلطة دنيوية (وليسوا كلهم كذلك)، وللإخوان من أصحاب كلّ صَاحبِ فكرةٍ علمانية.
فالمنهج الإخوانيّ منهج منحرفٌ عقائدياً، مداهنٌ عملياً، وما أخبث تلك الصورة التي ظهرت لعريانهم وهو يضحك مسبشراً مع عدو الله ورسوله الجمل يوم زيارته لمقرهم، وكأنه شرفٌ حظوا به، وياللعيب.
والمنهج السلفيّ وإن صحّ عقيدة فإنه يتميز بالسذاجة السياسية والحَوَل الوَاقعيّ، حيث أعطوا ثقتهم للعسكر والحكومة، كعادة بعضهم في مناصرة الحكام، او آخرين في ضعف الرؤية السياسية.
والمنهج السنيّ الوسطىّ، منهج أهل السنة، يعطى كلّ ذى حق حقه، بلا إفتئات ولا مداهنة، فالجمل كافر فاسق لا يحلّ لمسلمٍ في موقع مسؤلية أن يتعامل معه، والعسكر، كعادتهم، لا يؤمن شرّهم إلا وهم في ثكناتهم، لا دخل لهم بسياسة أو تقنين. والتغيير في مذهبنا لا يقف عند وسيلة واحدة، بل يسلك كل طريق وشعبة لإقرار حقّ الله على العبيد.