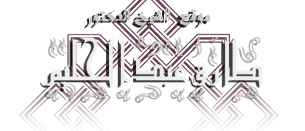الحمد لله والصلاة والسلام على رَسول الله صلى الله عليه وسلم
سَعِدتُ بتلك المُحاورات التي صَاحبت نشرَ مَقاليّ عن المُشاركة في العملية السياسية، والتي أظهرت وعياً عَميقاً وحِرصاً على الدليل من غالب من إهتم بالأمر من الشباب. لكنّ طبائع الأشياء والأحياء، تأبي إلا أن يكون هناك من يُعَانده عَقله وينازعه منطقه في مخالفة ما يهدى اليه الشرع ويدُل عليه العقل، لا قصداً للمُخالفة، ولا مُعاندة للشارع، بل لشدة الثقة بما يُسوّل له عقله أنه دليل لا يُدحَضُ ونظرٌ لا يُراجع. وسأحاول جَاهداّ في هذه العُجالة أن أعالجَ بعضاً مما قد أوقع هؤلاء في حيرة من أمرهم، أومن ثبُت على ما هداه إليه عقله، ظنّاً منه أن الثباتَ على القولِ قوةٌ في الدين وحِكمةٌ في النّظر وسَدادُ في الرأىٍ. ولولا حبى وحِرصى على هؤلاء الشَباب، ما شَغلتُ نفسى بهذا الأمر لحظة، إذ يعلم الله وَحده قدرَ ما ابتلانيَ به من مَشاغل.
الحديثُ في الشرع، حَديثٌ يَظهر أنه سَهلٌ ميسورٌ لبادِىَ الرأي. وكلما قلّ حَظُ المَرء من العِلم الشِرعيّ، كلما سَهل عليه الخوض فيه. لكن الأمر في حقيقته، على خلاف ذلك بالكلية. إذ إن العِلم الشرعيّ يُكتسَب من مَصَادر عدة، منها القراءة والتحصيل، في كافة فروعه، وفروع العلوم المُكمّلة كالتاريخ والعربية، ومنها البحث الذي يُنتج أعمالاً يتردد فيها نظر الباحث وقارئيه، موافقة ومخالفة، إنضاجاً له وتنقيحاً، ومنها الجُلوس إلى أصحاب العلم، لا لتلقى "معلومات" توجد في بطون الكتب، بل لإستيعاب طريقة في النظر والإستدلال، يختلطُ فيها الواقع بالعلم، ليُخرِجَ منهجاً يضعُ الأحكام الشرعية في مناطاتها الحَقة، وينزِل الوقائع الشرعية في سياقها الصّحيح. ومن أهم هذه المَصادر، أمر يغفل عن أهميته الكثير من الناس، وهو عامل الزمن. فالعلم في العقل، كالطعام على التنور، أو كالشَجرة في الأرض، كلما مرّ الوقت، كلما كان الطعام أنضج وأشهى، ولو استعجل الطّاهي، لأَكلَ الناسُ طَعَاماً رديئاً، ولو استعجَل الزارعُ، لقَطَفَ ثِمَاراً فَجّة. ومع مرور الزمن، تتراكمُ حكمة العلم التي تتوارى في مُستهل العمر، لتضيفَ أبعاداً يصعُب على المرءِ أن يحدّد مواردها، ومنها جاء لفظ "الشيخ"، يُطلقُ على صاحب العلم، صاحب النضج، معاً. فالأمر إذن ليس هو فقط الكمّ العلميّ ، بل الكمّ الذي ارتفع قدرُه بالكيف والوقت.
وأضرب مثلا من تعليقٍ جاء من أخٍ فاضلٍ، يرى أن الجِهاد هو أفضل طريق، قال "أما عن الطريق فلا أراه يخرج عن قوله تعالى: ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز)اهـ. قلت: الجهاد أفضل الفضائل وأوجب الواجبات، لا يجادل في هذا مسلمٌ، لكنه كغيره محكومٌ بما وضعه الله سبحانه شروطاً وموانع ليترتب عليه الثواب المأمول في الآخرة، ويقع به الغرض المقصود في الدنيا. ولو تأملتم معى قول الله تعالى الذي استشهد به الأخ الكريم، من سورة الحديد، لرأينا أنّ الله سبحانه قد جعل بأس الحديد قسِيماً لمَنافعه للناس، فجعل بذلك النفع فيه مقيداً، وإن لم يجعله ضَاراً كما في آية الخمر التي جعل فيها الإثم قسيماً للمنفعة، فحَرُمت. وهذا ما يعطينا دلالة إشارة إلى أنّ اللجوء للبأس لا يكون في صالح الناس إبتداءاً، فإن إنعدم طريقٌ آخر، ظَاهرُ المنافع، وجبَ اللجوءُ للبأس، وانحتمَ الجهاد وترتب الثواب. وهذا النظر تُعضّده أدلة الشرع كلها، فالله سبحانه لا يريد القتل للناس ابتداءاً، بل إنتهاءاً.
ثم أخٍ فاضلٍ آخر، قال :"1. لو قالت قريش: بإسمك "هبل" هل كان وافق الرسول صلى الله عليه وسلم مع العلم أن المصلحه المترتبة على ذلك ثابته لا تتغير . 2- لو عرض على الرسول أن يسجد لهبل أو يركع مره واحده على أن يحكم الجزيرة بل العالم كله بالإسلام فهل تتوقع يا شيخنا أنه كان من الممكن أن يوافق فإذا لم يفرط الرسول فى توحيد الربوبية لماذا نفرط نحن اليوم فى توحيد الألوهيه". وهو كلام جميلٌ ملئٌ بالحماس أكثر منه بتحرى الدليل ومَوضِعه من التطبيق.
فنقول، إن الإستشهاد بالحديبية لا يعنى إنها حالة مطابقةٌ لما نحن فيه مُطابقة تامة، بل ما يؤخذ منها هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع العدو، وإعتبار المآلات، وعدم الوقوف عند الظواهر، التي وإن كانت هامّة، إلا إنها قد توضَع جانباً لصالحِ ما هو أعلى منها مَرتبة، وأكثر أثراً في حياة الناس وبقاء الدعوة. ولو أن قريش أرادت وضع بإسمك "هبل"، لردها الرسول صلى الله عليه وسلم، بلا خلاف. لكن السؤال: هل ما نحن فيه من باب "باسمك هبل" أم من باب رفع صفة الرسالة عنه صلى الله عليه وسلم؟ وما يجب تبيانه هنا أن استخدام الفاظ مُشتركة مُوهِمة، قد تفقد دلالتها الأصلية في واقع إستعماليّ معينٍ، ويحتاج الأمر إلى الإتفاق على تعريفها، كما فعل شيخا الإسلام بن تيمية وبن القيم، في بيان كلمة "الصُوفية"، حيث قالا "إن كان المقصود منها كذا فهي كفرٌ أو بدعة، وإن كان المقصود بها كذا، فهى مما تحتمله السّنة" والبُعد عن هذا إستعمالها أفضل وأسلم في كل حالٍ، كما أرى. وهذا مما نحن فيه من اشتباه ألفاظ دارجةٍ الإستعمال مثل الديموقراطية، التي إن قُصد بها أنّ حُكمَ الشعب فوق حُكم الله كانت كفراً، وإن قصد بها مجرد استعمالٍ سياسيّ حديثٍ لمفهوم الشُورى، فيحتملها الشَرع، والعدول عنها أولى وأصحّ، بل لا يصح أن يكون استعمالها باباً لتألفِ قلوبِ الكفار، إذ في ذلك من الإيهام والتدليس ما فيه. لكنّ هذا الإشتراك الإستعماليّ الذي يقعُ في اللفظ ،ويحتاجُ المرءُ فيه إلى تَعريفِ مُعرّفها، لا يرقى، في تَحليلنا، إلى أن يُترك أمْر الحُكم للعلمانيين، يَحكموا مصر ويضيّعوا الشريعة بالكامل. هذا يكون من خَطلِ الرأي وتهافتِ النظر. صحيحٌ أنّ العلمانيين اللادينيين يستعملونها بِصفتها الكفرية، لكن قريشاً كذلك قد رفعت الصّفة الرسالية عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كفريّ بحت، وعبّرت عنه بقولها "لو كنا نعلم إنك رسول الله حقا لإتبعناك"، فرَفْع الصّفة لم يكن أمراً ظاهراً أو من باب التفاخر بالأنساب، أو ما إلى ذلك، بل كان جَحداً مُعلناً لصِفَته، وهو كفرٌ بلا خلاف. وعامة الناس، بل من المثقفين منهم، من يفهم الديموقراطية كأنها قسيمة الشورى، وهو ما يوجب البيان، وما يرفع حُكم الكفر إبتداءاً على من إستعملها.
لا يقال، ولكنّ هذا هو مَنهج الإخوان، ومن دَخلوا البرلمانات السّابقة، فنقول: إنّ فِعلهم، في ذاك الواقع، كفرٌ بلا خِلافٍ، إذ تلك المَجالس كانت مؤسّسة على الكفر إبتداءاً واستمراراً. لكن رغم أن هذا الفعل كفر ظاهرٌ في الجملة، إلا إن إيقاعه على المُعّين يخضع للشروط والموانع التي حدّدها الشرع، ومنها التأويلٌ المَرجوحٌ أو الفاسِد الذي يدرأ الكفر، طبقاً لقاعدة " أن الحدود تُدرأ بالشبهات"، وذلك في السرقة وغيرها من الفروع، فما بالك بالكفر إن وقعت فيه الشبهة. ولا يقال إنّ صِيغة الإعلان الدُستورى تحمل نفس المعنى، لأنّ الإعلان الدستورى ذاته خاضعٌ للتبديل، حين يأتي نواب الشعب بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وهو ما نأمله، وإن كنا نشك فيه، لما عرفنا من خُنوع الإخوان وولائهم للواقع القائم. لكن هذا الشك أمرٌ، وحِلّ المُشاركة أمرٌ آخر. والوضع إذن، في الغالب، وضعٌ إنشائيّ جديدٌ، وما غَلُبِ على الظّن أُجرى مَجرى اليقين، حتى يثبت عكسه. ولذلك نجد أنّ اللادينيين يُصارعون من أجل وَضعِ ما أسموه "مواد فوق دستورية"، ما أنزل الله بها من سلطان، لعلمهم أن ما هو قائمٌ اليوم ليس له صِفة حَقيقية، ولا يُلزِم أحداً، فيريدون إذن أن تُفرضَ من الآن مَوادٌ لا يمَسها واضعوا الدستور القادم. فإن نَجَحوا في ذلك، تعيّن هَجرُ الصَناديق والبدء في التحضِير للبناديق. أما عن الجزء الثاني من السؤال، فليس له موقعٌ فيما نحن فيه.
ثم أخٍ ثالثٍ، تعدّى وتجَاوز في تعليقه، قال، بعد أن سَفّه الكاتب واستهزأ به، جزاه الله خيراً، ما معناه: "إن هذا تحكمٌ من الشيوخ الذين قالوا أمراً من قبل ثم رجعوا عنهن وتمَحّكوا بِشُبه رَفضوها من قبل، وأنكروا على تلامذتهم ممن خالفهم، فيما أخطئوا فيه، كما يفعل أدعياء السلفية". وهذا أمرٌ لو صَحّ لكان منكراً، ولو كان مثل الشَيخ الجليل الشاذليّ ومثلي، عَدلا عما قالا في تحريم المُشاركة في عهد مبارك، دون دليل واضحٍ جليّ، لكان لما يقوله الأخ وجهاً، لكن هذا ليس عدولاً عن فتوى، بل هى فتوى جديدة لواقع جديد كُلّ الجِدّة، فيما نرى. ثم مَنِ الحَكَم في تحديد من أخطأ، طالب العلم المبتدئ أم مُعلِمه؟ كيف وصل الأخ إلى حقيقة أنّ ما ذهب اليه من رآهم مشايخه من قبل، هو خطأٍ الآن؟ ومن يَضمَن له أنّ هناك أبعادا لا يراها طالب العلم، الذي سلّم لشيخه من قبل، فلما جاء الشيخ بما لا يُحب الطالب، خالفه، بل واتهمه في دينه وعِلمه؟ وما هو الجَديد الذي جعل مشايخه ينحدرون إلى هذا القاع الغائر؟ وأين هي المناصب التي يسعى وراءها مثل الشيخ الشاذليّ حفظه الله، أو مثلى، ممن لا يقدر حتى على دخول أرض مصر أصلاً؟ واين أئمتك وعلمائك من الذين أفتوا لك بما تقول، أم أفتيت لنفسك، رَحِمك الله؟
الأمر إذن يجب أن يتحَرّى فيه الناظر كلّ أبعاد النظر، في العِلم، ودراسة الواقع، والفتاوى السابقة، والقدرة على الإستنباط إبتداءاً، التي تختلف بين الناس إختلافهم في الرِزق، ثم حِكمة السّنين وعَطاء الشيْب للناظرين. فإن فعل، فلا غَضَاضة في المخالفة ساعتها.